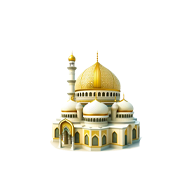في يوم الجمعة 9 رمضان عام 1436 للهجرة، الموافق 26 يونيو من عام 2015 ميلادي، دخل انتحاري إلى «مسجد الإمام جعفر الصادق» في الكويت، ففجر نفسه بحزام جهنمي فتمزق مزعاً، وأخذ معه إلى عالم القبور من جمهور المصلين 27 شخصاً، وترك وراءه 222 جريحاً ومعاقاً.
وفي اليوم نفسه، إلى الغرب في تونس، حيث يتشمس الأجانب من إيطاليين وألمان وبريطانيين وفرنسيين في منتجع «سوسة» السياحي، هجم عليهم إرهابي من البحر وبيده قنابل ورشاش، فحصد من أرواح المصطافين الأجانب في دقائق معدودة 37 روحاً، وحرصاً على سلامتهم، فقد رافقهم إلى العالم الأخروي!
وإلى الشمال على الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، هجم رجل متحمس على مصنع للغاز في مدينة «ليون» في فرنسا، وحاول تفجير المصنع، وترك خلفه رأساً مقطوعاً على السلم!
وقبل أسابيع هجم أيضاً إرهابي على مسجد القديح في المنطقة الشرقية من السعودية، ففجر نفسه يوم الجمعة، حيث يحتشد الناس ويركعون، وبعده بأسبوع في الدمام من المنطقة نفسها، وفي موعد مشابه، قام شخص آخر بتفجير نفسه هو أيضاً، فحمل الاثنان معهما إلى عالم القبور عشرات القتلى، وخلّفا عشرات الجرحى والمعاقين إلى يوم الدين.
وفي مطلع رمضان الجاري، قتل تنظيم «داعش» عشرين كردياً بطريقة وصفت بالبشعة. وقبل ذلك كان التنظيم قد قام بأسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي كان يمطرهم بشواظ من نار ونحاس، فأحرقوه حياً وهم يصورون فعلتهم بحق الرجل بكاميرا الديجتال ويوزعون الفيلم على العالم.. فما هي أسباب ثقافة؟ ومن أين جاءت؟
المؤشرات تقول، إن المساجد وأماكن العبادة، حيث يتجمع الناس، وكذلك أماكن التجمع الأخرى مثل المصائف والمسارح والمزارات السياحية ومتاحف الفنون والآثار وقاعات السينما والفنادق (وقد قُتل العقاد وابنته في أحد فنادق عمّان).. أصبحت أماكن في غاية الخطورة، إذ مستهدفة وعلى المرء تجنبها ما أمكن.
وهذه القصص تذكرنا بقصص أخرى؛ فقد تم قتل «بيار الجميل» في 21 نوفمبر 2006، وكان وزيراً للصناعة في لبنان، ضرباً بالرصاص في سيارته. وهو ليس الأول ولن يكون الأخير في ساحة لبنان، ومن قبل قدم المجرمون قرباناً في أعياد الميلاد في 12 ديسمبر 2005، حيث تم نسف «جبران تويني»، النائب البرلماني ورئيس تحرير جريدة «النهار»، على الطريقة التقليدية: سيارة مفخخة، وأشلاء متناثرة.
وفي كلا المشهدين تطالعنا الصورة نفسها: نساء باكيات نادبات ووجوه مكفهرة حزينة، واتهامات متبادلة البريء الوحيد فيها الشيطان، وشياطين الإنس المجرمون عددهم كرمل عالج.
والقتل هو طريقة تصفية الحساب بين السياسيين، ومن يدفع ثمنه غالباً هم المفكرون وشخصيات المجتمع المهمة.
ومن قبل طلب بنو إسرائيل قرباناً تأكله النار، فقال القرآن:
«قل قد جاءكم رُسلٌ من قبْلي بالبيِّنات وبالذي قُلتُمْ فلِمَ قتَلتُموهمْ إن كنتُم صادقين؟». وفي الإنجيل، فإن شمس الله تشرق على الأبرار والأشرار.
سألت الملائكة عن جدوى هذا الخلق، فلم يؤرقها «الكفر»، بل «القتل»: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟». وكأن القتل هو الكفر مكثفاً، لكن الجواب الإلهي أنه رأى جانباً مختلفاً لم يتحقق بعد: «قال إني أعلم ما لا تعلمون».
ولعل تلك المقدمة تختصر ثلاثة أشياء: أن القتل أم المعضلات الإنسانية. وأن أفظع القتل هو قتل الإنسان أخيه الإنسان من أجل اختلاف وجهات النظر. وأن هناك برمجة في الكون سوف تتمخض عن استبدال ثقافة القرابين البشرية بثقافة السلام.
والإنسان اليوم يراوح بين التخوف الذي عبّر عنه الملائكة، أي الفساد والقتل، و«علم الله» فيه.
الدكتور خالص جلبي
وفي اليوم نفسه، إلى الغرب في تونس، حيث يتشمس الأجانب من إيطاليين وألمان وبريطانيين وفرنسيين في منتجع «سوسة» السياحي، هجم عليهم إرهابي من البحر وبيده قنابل ورشاش، فحصد من أرواح المصطافين الأجانب في دقائق معدودة 37 روحاً، وحرصاً على سلامتهم، فقد رافقهم إلى العالم الأخروي!
وإلى الشمال على الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، هجم رجل متحمس على مصنع للغاز في مدينة «ليون» في فرنسا، وحاول تفجير المصنع، وترك خلفه رأساً مقطوعاً على السلم!
وقبل أسابيع هجم أيضاً إرهابي على مسجد القديح في المنطقة الشرقية من السعودية، ففجر نفسه يوم الجمعة، حيث يحتشد الناس ويركعون، وبعده بأسبوع في الدمام من المنطقة نفسها، وفي موعد مشابه، قام شخص آخر بتفجير نفسه هو أيضاً، فحمل الاثنان معهما إلى عالم القبور عشرات القتلى، وخلّفا عشرات الجرحى والمعاقين إلى يوم الدين.
وفي مطلع رمضان الجاري، قتل تنظيم «داعش» عشرين كردياً بطريقة وصفت بالبشعة. وقبل ذلك كان التنظيم قد قام بأسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي كان يمطرهم بشواظ من نار ونحاس، فأحرقوه حياً وهم يصورون فعلتهم بحق الرجل بكاميرا الديجتال ويوزعون الفيلم على العالم.. فما هي أسباب ثقافة؟ ومن أين جاءت؟
المؤشرات تقول، إن المساجد وأماكن العبادة، حيث يتجمع الناس، وكذلك أماكن التجمع الأخرى مثل المصائف والمسارح والمزارات السياحية ومتاحف الفنون والآثار وقاعات السينما والفنادق (وقد قُتل العقاد وابنته في أحد فنادق عمّان).. أصبحت أماكن في غاية الخطورة، إذ مستهدفة وعلى المرء تجنبها ما أمكن.
وهذه القصص تذكرنا بقصص أخرى؛ فقد تم قتل «بيار الجميل» في 21 نوفمبر 2006، وكان وزيراً للصناعة في لبنان، ضرباً بالرصاص في سيارته. وهو ليس الأول ولن يكون الأخير في ساحة لبنان، ومن قبل قدم المجرمون قرباناً في أعياد الميلاد في 12 ديسمبر 2005، حيث تم نسف «جبران تويني»، النائب البرلماني ورئيس تحرير جريدة «النهار»، على الطريقة التقليدية: سيارة مفخخة، وأشلاء متناثرة.
وفي كلا المشهدين تطالعنا الصورة نفسها: نساء باكيات نادبات ووجوه مكفهرة حزينة، واتهامات متبادلة البريء الوحيد فيها الشيطان، وشياطين الإنس المجرمون عددهم كرمل عالج.
والقتل هو طريقة تصفية الحساب بين السياسيين، ومن يدفع ثمنه غالباً هم المفكرون وشخصيات المجتمع المهمة.
ومن قبل طلب بنو إسرائيل قرباناً تأكله النار، فقال القرآن:
«قل قد جاءكم رُسلٌ من قبْلي بالبيِّنات وبالذي قُلتُمْ فلِمَ قتَلتُموهمْ إن كنتُم صادقين؟». وفي الإنجيل، فإن شمس الله تشرق على الأبرار والأشرار.
سألت الملائكة عن جدوى هذا الخلق، فلم يؤرقها «الكفر»، بل «القتل»: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟». وكأن القتل هو الكفر مكثفاً، لكن الجواب الإلهي أنه رأى جانباً مختلفاً لم يتحقق بعد: «قال إني أعلم ما لا تعلمون».
ولعل تلك المقدمة تختصر ثلاثة أشياء: أن القتل أم المعضلات الإنسانية. وأن أفظع القتل هو قتل الإنسان أخيه الإنسان من أجل اختلاف وجهات النظر. وأن هناك برمجة في الكون سوف تتمخض عن استبدال ثقافة القرابين البشرية بثقافة السلام.
والإنسان اليوم يراوح بين التخوف الذي عبّر عنه الملائكة، أي الفساد والقتل، و«علم الله» فيه.
الدكتور خالص جلبي