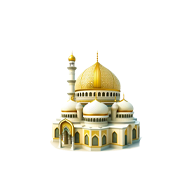| والحق ما شهدت به الأعداء.. |
 |
 |
للمستشرق – البريطاني الأصل، الأمريكي الجنسية، الصهيوني الهوى - "برنارد لويس" عداء شهير للصحوة الإسلامية المعاصرة، لكنه في علاقة الإسلام – كدين – بالدولة، وفي الموقف من الدولة العثمانية وتأثيراتها الإسلامية في أوروبا، يقدم شهادة خبير على ذلك يقول:
"لقد نادى مؤسس المسيحية أتباعه: أن "أعطو ما لقيصر لقيصر وما لله لله".. أما مؤسس الإسلام فقد جعل من نفسه "قسطنطين" (274 – 337 م) ففي حياته أصبح المسلمون جماعة سياسية ودينية، كان الرسول سيدها المطلق، يحكم أرضا وشعبا، ويقضي بين الناس، ويجمع الضرائب، ويقود الجيوش ويسير الدبلوماسية ويخوض الحروب.
ولقد كانت الخلافة نظام حكم حدده الإسلام، وحل الدين محل القرابة، كأساس للهوية الجماعية والولاء، كما حل محل العرف، أو أقره بوصفه قانون الجماعة.

والواقع أنه لم يكن يوجد في المفهوم الإسلامي مقابل حقيقي لمثل تلك الأضداد: ديني ودنيوي، روحي وزمني، كهنوتي وعلماني، وحتى المقدس والمدنس، ولم يظهر مثل هذا إلا بعد وقت طويل جدا، حين استحدثت كلمات جديدة للتعبير عن مفاهيم جديدة، أما في العهد الأول للإسلام فلم تكن الثنائية التي تدل عليها تلك الكلمات معروفة، لذلك لم يكن هناك من كلمات للتعبير عنها.
ولقد قيل: إن الخليفة يجمع في آن واحد بين شخصيتي البابا والإمبراطور، على أن هذا التشبيه مضلل، فلم تكن للخليفة وظائف بابوية أو كهنوتية، ولم يكن واجبه عرض الدين ولا تفسيره، بل كان واجبه هو دعمه وحمايته وإيجاد الظروف التي من شأنها أن تمكن الناس من العيش حياة إسلامية صالحة في هذه الدنيا، وبذلك يعدون أنفسهم للحياة الآخرة، ولتحقيق ذلك يتوجب عليه أن يحافظ على القانون والنظام ضمن حدود الإسلام وأن يدافع عن هذه الحدود ضد الهجمات الخارجية.

والواقع أن الذي غزا أتراك آسيا الوسطى، لم يكن المسلمين، بل كان الإسلام ذاته، فقد كان المتصوفون والدعاة المتجولون – ومعظمهم من الأتراك – يتنقلون بين القبائل فيما وراء وراء النهر، ينشرون الدين البسيط، دين الكفاح الذي ازدهر على الحدود بين الإسلام والوثنية.
وعندما انتهى الحكم العثماني في أوروبا، كانت الأمم المسيحية التي حكمها العثمانيون خلال عدة قرون لا تزال هناك بلغاتها وثقافتها ودياناتها وحتى إلى حد ما بمؤسساتها، كل هذه الأمور بقيت سليمة جاهزة لاستئناف وجودها الوطني المستقل، أما في أسبانيا وصقلية فليس فيها اليوم مسلمون أو ناطقون باللغة العربية.

إن الفلاحين في المناطق الأوروبية التي غزاها العثمانيون، فقد تمتعوا بتحسن كبير في أوضاعهم، فقد جلب العثمانيون لهم الوحدة والأمن مكان الصراع والفوضى، كما ترتب على الحكم العثماني نتائج إجتماعية وإقتصادية مهمة، فلقد امتلكوا الأرض وتوارثوها، وتمتعوا بقدر من الحرية في حقولهم أكبر بكثير من ذي قبل، وخففت عنهم الضرائب التي كانت تجمع بطرق إنسانية، وذلك بالمقارنة بما كان يجري في أنظمة الحكم السابقة والمجاورة، وهذا يفسر الهدوء الطويل الذي ساد الولايات العثمانية في أوروبا حتى تفجرت الأفكار القومية التي جاءت من الغرب.
لقد كانت الإمبراطورية العثمانية، بالإضافة إلى كونها عدوا خطرا لأوروبا، ذات سحر قوي يجذب الذين تتاح لهم فرصة العيش في ظل التسامح العثماني.
وكان الفلاحون المسحوقون تحت سلطة أمراء الإقطاع الأوروبيين يتطلعون بأمل إلى العثمانيين، حتى أن "مارتن لوثر" (1483 – 1546 م) في مؤلفه "النصح بالصلاة ضد الأتراك" قد حذر من تفضيل الفقراء المضطهدين على يد الأمراء وأصحاب الأملاك العيش في ظل الأتراك بدلا من المسيحيين من أمثال هؤلاء!
وعندما وصل "فاسكو دي جاما" (1469 – 1524 م) إلى الهند قال إنه أتى بحثا عن التوابل والمسيح! ومان هذا تلخيصا صادقا للدوافع التي أرسلت البرتغاليين إلى آسيا، فلقد كانت الشعور الديني قويا عند البرتغاليين الذين ذهبوا إلى الشرق، وكانت رحلاتهم نضالا دينيا واستمرار للحروب الصليبية، وكفاحا ضد العدو الإسلامي، وبعد البرتغاليين جاء الإسبان والفرنسيون والأنجليز والهولنديون الذين أسسوا السيطرة الأوربية على أفريقيا وآسيا والتي دامت حتى القرن العشرين"