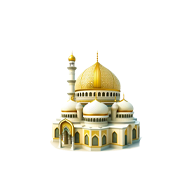الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا لقاء مبارك متجدد حول تأملات في كتاب ربنا جل وعلا، وكنا في اللقاء الماضي قد أنهينا بعض التأملات حول سورة يوسف، ومما ذكرناه فيها: أن الله جل وعلا نعت هذا النبي الكريم ببعض الصفات، وقلنا إن ثمة خصائص تميز بها نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي على وجه الإجمال كالتالي:
أولها: نسبه وشرف معدنه، وقلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: (هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم)، وقال: (يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله).
والثاني: إن الله آتاه النبوة.
والثالث: جمال الخلقة؛ لذا قال الله عن النسوة: فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ [يوسف:31].
والرابع: حسن الأدب مع الله، وحسن الأدب مع من كرمه وأحسن إليه، وعفوه عمن أساء إليه، وقلنا: إن كرمه مع من أحسن إليه يتمثل في قوله: مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ [يوسف:23]، وقلنا: إن ( ربي ) هنا لها معنيان: الأول: أن يكون الرب هو الله جل جلاله، والثاني: العزيز، وبالأول قال جمع من العلماء، لكن رجحنا: أن المقصود بربي هنا: سيدهم، وهو عزيز مصر الذي اشتراه.
والدليل على أنه أراد بقوله: إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ [يوسف:23] العزيز أنه عندما اشتراه قال لزوجته: أَكْرِمِي مَثْوَاهُ [يوسف:21]، فهذه قرينة على أن المراد به سيده، وليس المراد به ربه جل وعلا.
فهذا بعض ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي.
وسنتكلم -إن شاء الله تعالى- ونتأمل في سورة الرعد وهي سورة مكية، وسميت بسورة الرعد لقول الله جل وعلا فيها: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ [الرعد:13].
وهذه السورة تعنى بشئون العقيدة، وتثبيت مكارم الأخلاق، كما هو شأن أكثر السور المكية، وليس فيها من الأحكام الفقهية شيء كثير كنظيراتها من السور المكية الأخرى.
يقول ربنا جل وعلا: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا [الرعد:2]، هذه الآية فيها إشكال؛ لأن الله لم يفصل بين ( عمد ) و( ترونها )، وقد كان بعض النساء العالمات يلغزن بها، ولا حاجة للتفصيل لكن نقول معنى قوله تعالى: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا [الرعد:2]، يحتمل أمرين:
الأمر الأول: أن يكون للسماء عمد لكنها لا ترى، فيصبح الإعجاز في عدم قدرتنا على رؤية العمد التي تتكئ عليها السماء، وهذا قول قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال به بعض العلماء.
الأمر الثاني: وهو قول جمهور العلماء: أن السماء ليس لها عمد أصلاً، وإنما جيء بجملة (ترونها) المتكونة من فعل وفاعل ومفعول به متصل، لتأكيد النفي، والمنفي هنا أن يكون للسماء عمد، وهذا القول يؤيده قول الله جل وعلا: وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ [الحج:65].
وما يؤيده القرآن من رأي أولى من رأي لا نرى له دليلاً من القرآن ومؤيداً.
فنحن لا نعلم في القرآن دليلاً يؤيد الرأي القائل بأن لها عمداً، لكن نعلم أن في القرآن دليلاً يؤيد القول بأنه ليس لها عمد، وهو قول الله جل وعلا: وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ [الحج:65].
والقول بأنه ليس لها عمد أليق بالقدرة الإلهية، وهذا ظاهر المعنى، وإن كان لو فرض أنه ثبت بعد ذلك أن لها عمداً فلا يغير من قدرة الله شيئاً، وخلق السماء والأرض أكبر من خلق الناس، قال الله تعالى: لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ [غافر:57]، فخلق السماوات والأرض يدل على أن السماوات مخلوقات عظيمة.
وبينا أن الله جل وعلا خلق الأرض أولاً في يومين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها جل وعلا في يومين، ثم عاد تبارك وتعالى إلى الأرض فأكمل خلقها ودحاها، وقدر فيها أقواتها، وقال سبحانه عنها: وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ [فصلت:10]، فهذه خاصة بالأرض، وقال عن السماء: فِي يَوْمَيْنِ [فصلت:12] فأصبحت ستاً، ولذلك قال جل وعلا في النازعات: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا [النازعات:27-29]، ثم قال: وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا [النازعات:30].
ولم يقل: خلقها؛ لأنه قد ابتدأ خلقها قبل خلق السماء.
والذي يعنينا أن السماء لها أبواب، وقلنا: إن هذه الأبواب التي في السماء من خلالها تصعد أرواح المؤمنين، أما الكفار فيقول الله جل وعلا عنهم: لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ [الأعراف:40]، فدل على أن أبواب السماء تفتح لأرواح المؤمنين، قال الله جل وعلا عن آل فرعون: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ [الدخان:29].
وقيل في تفسيرها: إن العبد الصالح إذا كان حياً يعيش ورفعت له أعمال صالحة، إذا مات تفقده الجهة التي كان يرفع منها عمله، فإذا فقدت السماء عمل المؤمن الصالح الذي يرفع من خلالها تبكي عليه، فلما كان آل فرعون لا يرفع لهم عمل قال الله جل وعلا: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ [الدخان:29].
أما بعد:
فهذا لقاء مبارك متجدد حول تأملات في كتاب ربنا جل وعلا، وكنا في اللقاء الماضي قد أنهينا بعض التأملات حول سورة يوسف، ومما ذكرناه فيها: أن الله جل وعلا نعت هذا النبي الكريم ببعض الصفات، وقلنا إن ثمة خصائص تميز بها نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي على وجه الإجمال كالتالي:
أولها: نسبه وشرف معدنه، وقلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: (هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم)، وقال: (يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله).
والثاني: إن الله آتاه النبوة.
والثالث: جمال الخلقة؛ لذا قال الله عن النسوة: فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ [يوسف:31].
والرابع: حسن الأدب مع الله، وحسن الأدب مع من كرمه وأحسن إليه، وعفوه عمن أساء إليه، وقلنا: إن كرمه مع من أحسن إليه يتمثل في قوله: مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ [يوسف:23]، وقلنا: إن ( ربي ) هنا لها معنيان: الأول: أن يكون الرب هو الله جل جلاله، والثاني: العزيز، وبالأول قال جمع من العلماء، لكن رجحنا: أن المقصود بربي هنا: سيدهم، وهو عزيز مصر الذي اشتراه.
والدليل على أنه أراد بقوله: إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ [يوسف:23] العزيز أنه عندما اشتراه قال لزوجته: أَكْرِمِي مَثْوَاهُ [يوسف:21]، فهذه قرينة على أن المراد به سيده، وليس المراد به ربه جل وعلا.
فهذا بعض ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي.
وسنتكلم -إن شاء الله تعالى- ونتأمل في سورة الرعد وهي سورة مكية، وسميت بسورة الرعد لقول الله جل وعلا فيها: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ [الرعد:13].
وهذه السورة تعنى بشئون العقيدة، وتثبيت مكارم الأخلاق، كما هو شأن أكثر السور المكية، وليس فيها من الأحكام الفقهية شيء كثير كنظيراتها من السور المكية الأخرى.
يقول ربنا جل وعلا: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا [الرعد:2]، هذه الآية فيها إشكال؛ لأن الله لم يفصل بين ( عمد ) و( ترونها )، وقد كان بعض النساء العالمات يلغزن بها، ولا حاجة للتفصيل لكن نقول معنى قوله تعالى: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا [الرعد:2]، يحتمل أمرين:
الأمر الأول: أن يكون للسماء عمد لكنها لا ترى، فيصبح الإعجاز في عدم قدرتنا على رؤية العمد التي تتكئ عليها السماء، وهذا قول قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال به بعض العلماء.
الأمر الثاني: وهو قول جمهور العلماء: أن السماء ليس لها عمد أصلاً، وإنما جيء بجملة (ترونها) المتكونة من فعل وفاعل ومفعول به متصل، لتأكيد النفي، والمنفي هنا أن يكون للسماء عمد، وهذا القول يؤيده قول الله جل وعلا: وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ [الحج:65].
وما يؤيده القرآن من رأي أولى من رأي لا نرى له دليلاً من القرآن ومؤيداً.
فنحن لا نعلم في القرآن دليلاً يؤيد الرأي القائل بأن لها عمداً، لكن نعلم أن في القرآن دليلاً يؤيد القول بأنه ليس لها عمد، وهو قول الله جل وعلا: وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ [الحج:65].
والقول بأنه ليس لها عمد أليق بالقدرة الإلهية، وهذا ظاهر المعنى، وإن كان لو فرض أنه ثبت بعد ذلك أن لها عمداً فلا يغير من قدرة الله شيئاً، وخلق السماء والأرض أكبر من خلق الناس، قال الله تعالى: لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ [غافر:57]، فخلق السماوات والأرض يدل على أن السماوات مخلوقات عظيمة.
وبينا أن الله جل وعلا خلق الأرض أولاً في يومين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها جل وعلا في يومين، ثم عاد تبارك وتعالى إلى الأرض فأكمل خلقها ودحاها، وقدر فيها أقواتها، وقال سبحانه عنها: وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ [فصلت:10]، فهذه خاصة بالأرض، وقال عن السماء: فِي يَوْمَيْنِ [فصلت:12] فأصبحت ستاً، ولذلك قال جل وعلا في النازعات: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا [النازعات:27-29]، ثم قال: وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا [النازعات:30].
ولم يقل: خلقها؛ لأنه قد ابتدأ خلقها قبل خلق السماء.
والذي يعنينا أن السماء لها أبواب، وقلنا: إن هذه الأبواب التي في السماء من خلالها تصعد أرواح المؤمنين، أما الكفار فيقول الله جل وعلا عنهم: لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ [الأعراف:40]، فدل على أن أبواب السماء تفتح لأرواح المؤمنين، قال الله جل وعلا عن آل فرعون: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ [الدخان:29].
وقيل في تفسيرها: إن العبد الصالح إذا كان حياً يعيش ورفعت له أعمال صالحة، إذا مات تفقده الجهة التي كان يرفع منها عمله، فإذا فقدت السماء عمل المؤمن الصالح الذي يرفع من خلالها تبكي عليه، فلما كان آل فرعون لا يرفع لهم عمل قال الله جل وعلا: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ [الدخان:29].