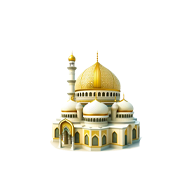هل معنى حديث ( شقي أو سعيد ) الشقاء والسعادة في الدنيا ؟
السؤال:
كنت أنا وبعض الإخوة في الله نناقش مغزى حديث رسولنا الكريم الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : حدَّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم ليُجمع خلْقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الله إليه الملَك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد ، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) متفق عليه ، صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم . ومن المعلوم أننا كمسلمين يجب أن نؤمن بلب هذا الحديث إيماناً راسخاً ، ولكن وردت الأسئلة التالية أثناء النقاش ، ولقلة زادنا الشرعي : رغبنا أن نستزيد من علمكم : 1. هل السعادة والشقاء من منظور شرعي - التي وردت في الحديث - هما نفس السعادة والشقاء من منظور حسي - أي : التي نعيشهما ، ونحسهما في هذه الدنيا الفانية ؟ . 2. هل يمكن للإنسان أن يعرف مع أيِّ الفريقين هو ؟ هل هناك علامات نستدل بها ؟ . 3. في واقعنا الإنساني نجد بعض القصور في التسليم بذلك - أي : بما ورد في الحديث - فهل هذا يعتبر قصوراً في الدين ، أو التقوى ؟ . 4. بسبب طبيعتنا الإنسانية نتذمر في العادة عندما يتلبسنا الإحساس بالتعاسة ، هل ذلك يعتبر إنكاراً لقدَر الله ؟ . 5. عندما تغمرنا السعادة من كل جانب ، وتنبسط لنا الدنيا : قلَّ أن ننسب ذلك لقدر الله ، ولكن نحاول الإيحاء أن ذلك بجهدنا ، وعلو همتنا ، هل هذا يعتبر نقضاً ، أو إنكاراً لقدر الله ؟ . نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر ، وأن ينفع الإسلام والمسلمين بجهودكم ، وعلمكم .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لفظا " السعادة " و " الشقاء " الواردان في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليسا هما ما نحسه في الدنيا من " سعادة " ، وما يصيبنا فيها من " شقاء " ، بل هما " الإسلام " و " الكفر " ، وهما الطريقان إلى " الجنة " و " النار " ، والمقصود بالحديث : ما يختم للإنسان بأحد الأمرين في الدنيا ، فمن ختم له بخير فهو سعيد ، وهو من أهل السعادة ، وجزاؤه الجنة ، ومن خُتم له بشرٍّ فهو شقي ، وهو من أهل الشقاء ، ومصيره النار – والعياذ بالله - .
وقد جاء هذا اللفظان في الكتاب والسنَّة بذات المعنى الذي قلناه :
أ. ( يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ . فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ . خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ . وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ) هود/ 105 – 108 .
ب. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنَّا فِى جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَإِلاَّ وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ) قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ فَقَالَ : ( اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ) ، ثُمَّ قَرَأَ ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ) .
رواه البخاري ( 4666 ) ومسلم ( 2647 ) .
( المِخصرة ) : ما اختصر الإنسان بيده ، فأمسكه من عصا ، أو عَنَزة .
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
وقد تكاثرت النُّصوص بذكرِ الكتابِ السابقِ ، بالسَّعادة والشقاوة ، ففي " الصحيحين " عن عليِّ بن أبي طالب – وذكر الحديث - .
ففي هذا الحديث : أنَّ السعادة ، والشقاوة : قد سبقَ الكتابُ بهما ، وأنَّ ذلك مُقدَّرٌ بحسب الأعمال ، وأنَّ كلاًّ ميسر لما خُلق له من الأعمال التي هي سببٌ للسعادة ، أو الشقاوة .
وفي " الصحيحين " عن عمرانَ بن حُصينٍ ، قال : قال رجل :يا رسول الله ، أيُعرَفُ أهلُ الجَنَّةِ مِنْ أهلِ النَّارِ ؟ قالَ : ( نَعَمْ ) ، قالَ : فَلِمَ يعملُ العاملونَ ؟ قال : ( كلٌّ يعملُ لما خُلِقَ له ، أو لما ييسر له ) .
وقد روي هذا المعنى عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ كثيرةٍ ، وحديث ابن مسعود فيه أنَّ السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال .
" جامع العلوم والحِكَم " ( ص 55 ) . وينظر : " فتح الباري " ( 11 / 483 ) .
ثانياً:
ما يشير إليه السائل من الغنى أو الفقر ، والصحة أو المرض ... ، وسائر ما يصيب الناس من السراء والضراء في عيشهم ، وهو ما يعنيه بقوله : السعادة والشقاوة من المنظور الحسي : هذا كله قد سبق به الكتاب ، من قبل أن تخلق السموات والأرض ، وقد كتب أيضا فيما كتب للجنين من رزقه : ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ) القرآن/49 .
وإنما يُعرف المؤمن أنه محقق للإيمان في هذا الباب ، وأنه مسلِّم لقدَر الله تعالى ، مؤمن به : إذا شكر ربه في السرَّاء ، وصبر عند الضرَّاء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
جعل اللهُ سبحانَه وتعالى لعباده المؤمنين بكل منزلة خيراً منه ، فهم دائماً في نعمةٍ من ربهم ، أصابَهم ما يُحِبَّون ، أو ما يكرهون ، وجعل أقضيته ، وأقداره التي يقضيها لهم ، ويُقدرها عليهم : متاجرَ يَربحون بها عليه ، وطُرُقًا يصلون منها إليه ، كما ثبت في الصحيح عَن إمامهم ومتبوعهم - الذي إذا دُعي يوم القيامة كلُّ أناسٍ بإمامهم دُعُوا به صلواتُ الله وسلامه عليه - أنه قال : ( عجبًا لأمر المؤمن ، إن أمره كله عجب ، ما يقضي الله له من قضاء إلاّ كان خيراً له، إن أصابته سرَّاءُ شكَرَ فكان خيراً له ، وإن أصابَتْه ضرَّاءُ صَبَر فكان خيراً له).
فهذا الحديث يَعمُّ جميعَ أَقضيتِه لعبده المؤمن ، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها ، وشكرَ لمحبوبها ، بل هذا داخلٌ في مسمَّى الإيمان ، فإنه كما قال السلف : " الإيمان نصفان ، نصفٌ صبر ، ونصفٌ شكر " ، كقوله تعالى : ( إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ) ، وإذا اعتَبر العبدُ الدينَ كلَّه : رآه يَرجِعُ بجملته إلى الصبر ، والشكر .
" جامع المسائل " ( 1 / 165 ) .
فعلى المسلم أن يؤمن بقدر الله تعالى خيره وشرِّه ، ولا يسعه غير ذلك ؛ لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان ، والذي لا يصح من غيره .
وعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله ، ويسلِّم لما يكتبه الله له ، أو عليه ؛ فإن في ذلك حكَم بالغة ، ولا يتعجل في النظر لظاهر الأمر أنه نعمة ، أو نقمة ، بل العبرة بما يترتب على ذلك من شكر للنعم ، ومن رضى بالمصائب ، فهمنا يكون مؤمناً محققا لما طلبه الله منه ، ويكون مستفيداً من ذلك دوافع تدفعه للعمل وعدم القنوط واليأس ، كما تدفعه لشكر الله تعالى لنيل المزيد منها .
ثالثاً:
ثمة علامات يمكن للمسلم أن يستدل بها على كون أصحابها من أهل الجنة ، أو أهل النار ؛ وذلك بحسب اتصافه بها ، وتخلقه بأخلاقها ، ظاهراً وباطناً ، وعليه بوَّب الإمام النووي رحمه الله بقوله في " شرح مسلم " : " بَاب الصِّفَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ " ، وقد جعل تبويبه هذا على حديث عياض بن حمار المجاشعي ، والذي رواه مسلم ( 2265 ) ، وفيه :
( وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ .
قَالَ :
وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ ) .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
( ذو سلطان مقسط موفق ) وهذا هو الشاهد ، يعني : صاحب سلطان ، والسلطان يعم السلطة العليا ، وما دونها .
( مقسط ) أي : عادل بين مَن ولاَّه الله عليهم .
( موَّفق ) أي : مهتد لما فيه التوفيق والصلاح ، قد هدى إلى ما فيه الخير .
فهذا من أصحاب الجنة .
( ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ) رجل رحيم ، يرحم عبادَ الله ، يرحم الفقراء ، يرحم العجزة ، يرحم الصغار ، يرحم كل من يستحق الرحمة .
( رقيق القلب ) ليس قلبه قاسياً .
( لكل ذي قربى ومسلم ) وأما للكفار : فإنه غليظ عليهم .
هذا أيضاً من أهل الجنة : أن يكون الإنسان رقيق القلب ، يعني : فيه لين ، وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم .
والثالث : ( رجل عفيف متعفف ذو عيال ) يعني : أنه فقير ، ولكنه متعفف لا يسأل الناس شيئاً يحسبه الجاهل غنيّاً من التعفف .
( ذو عيال ) أي : أنه مع فقره عنده عائلة ، فتجده صابراً ، محتسباً ، يكد على نفسه ، فربما يأخذ الحبل ويحتطب ويأكل منه ، أو يأخذ المخلب يحتش فيأكل منه ، المهم : أنه عفيف ، متعفف ، ذو عيال ، ولكنه صابر على البلاء ، صابر على عياله ، فهذا من أهل الجنة ، نسأل الله أن يجعلنا من أحد هؤلاء الأصناف .
" شرح رياض الصالحين " ( 3 / 648 ، 649 ) .
وقال النووي – رحمه الله - :
شرح النووي على مسلم - (17 / 199)
( الضعيف الذي لا زَبر له الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ، ولا مالاً ) .
فقوله ( زبر ) بفتح الزاي وإسكان الموحدة ، أي : لا عقل له يزبره ، ويمنعه مما لا ينبغى ، وقيل : هو الذي لا مال له ، وقيل : الذي ليس عنده ما يعتمده .
وقوله ( لا يتبعون ) بالعين المهملة ، مخفف ، ومشدد ، من الاتباع ، وفي بعض النسخ " يبتغون " بالموحدة والغين المعجمة ، أي : لا يطلبون .
قوله صلى الله عليه و سلم ( والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة ) معنى ( لا يخفى ) : لا يظهر ، قال أهل اللغة : يقال خفيت الشيء إذا أظهرته ، وأخفيته إذا سترته وكتمته ، هذا هو المشهور ، وقيل : هما لغتان فيهما جميعاً .
قوله ( وذكر البخل والكذب ) هي في أكثر النسخ ( أو الكذب ) بـ ( أو ) ، وفي بعضها ( والكذب ) ، بالواو ، والأول : هو المشهور في نسخ بلادنا ، وقال القاضي : روايتنا عن جميع شيوخنا بالواو إلا ابن أبي جعفر عن الطبري فبـ ( أو ) وقال بعض الشيوخ : ولعله الصواب ، وبه تكون المذكورات خمسة .
وأما ( الشنظير ) فبكسر الشين والظاء المعجمتين وإسكان النون بينهما ، وفسَّره في الحديث بأنه الفحَّاش ، وهو السيء الخلق .
" شرح مسلم " ( 17 / 199 ، 200 ) .
فليتأمل العبد الموفق ، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل علامة أهل الجنة في الآخرة أن يعملوا بأعمالهم في الدنيا ، وجعل علامة أهل النار في الآخرة أن يعملوا بأعمالهم في الدنيا .
قال الإمام أحمد رحمه الله : " سمعت سفيان بن عيينة يقول : من يزرع خيرا يحصد غِبطة ، ومن يزرع شرا يحصد ندامة ؛ تفعلون السيئات وترجون أن تُجْزَوُا الحسنات ؟!
أجل ؛ كما يجني من الشوك العنب !! "
"العلل ومعرفة الرجال" (2/373) .
السؤال:
كنت أنا وبعض الإخوة في الله نناقش مغزى حديث رسولنا الكريم الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : حدَّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم ليُجمع خلْقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الله إليه الملَك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد ، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) متفق عليه ، صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم . ومن المعلوم أننا كمسلمين يجب أن نؤمن بلب هذا الحديث إيماناً راسخاً ، ولكن وردت الأسئلة التالية أثناء النقاش ، ولقلة زادنا الشرعي : رغبنا أن نستزيد من علمكم : 1. هل السعادة والشقاء من منظور شرعي - التي وردت في الحديث - هما نفس السعادة والشقاء من منظور حسي - أي : التي نعيشهما ، ونحسهما في هذه الدنيا الفانية ؟ . 2. هل يمكن للإنسان أن يعرف مع أيِّ الفريقين هو ؟ هل هناك علامات نستدل بها ؟ . 3. في واقعنا الإنساني نجد بعض القصور في التسليم بذلك - أي : بما ورد في الحديث - فهل هذا يعتبر قصوراً في الدين ، أو التقوى ؟ . 4. بسبب طبيعتنا الإنسانية نتذمر في العادة عندما يتلبسنا الإحساس بالتعاسة ، هل ذلك يعتبر إنكاراً لقدَر الله ؟ . 5. عندما تغمرنا السعادة من كل جانب ، وتنبسط لنا الدنيا : قلَّ أن ننسب ذلك لقدر الله ، ولكن نحاول الإيحاء أن ذلك بجهدنا ، وعلو همتنا ، هل هذا يعتبر نقضاً ، أو إنكاراً لقدر الله ؟ . نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر ، وأن ينفع الإسلام والمسلمين بجهودكم ، وعلمكم .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لفظا " السعادة " و " الشقاء " الواردان في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليسا هما ما نحسه في الدنيا من " سعادة " ، وما يصيبنا فيها من " شقاء " ، بل هما " الإسلام " و " الكفر " ، وهما الطريقان إلى " الجنة " و " النار " ، والمقصود بالحديث : ما يختم للإنسان بأحد الأمرين في الدنيا ، فمن ختم له بخير فهو سعيد ، وهو من أهل السعادة ، وجزاؤه الجنة ، ومن خُتم له بشرٍّ فهو شقي ، وهو من أهل الشقاء ، ومصيره النار – والعياذ بالله - .
وقد جاء هذا اللفظان في الكتاب والسنَّة بذات المعنى الذي قلناه :
أ. ( يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ . فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ . خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ . وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ) هود/ 105 – 108 .
ب. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنَّا فِى جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَإِلاَّ وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ) قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ فَقَالَ : ( اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ) ، ثُمَّ قَرَأَ ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ) .
رواه البخاري ( 4666 ) ومسلم ( 2647 ) .
( المِخصرة ) : ما اختصر الإنسان بيده ، فأمسكه من عصا ، أو عَنَزة .
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
وقد تكاثرت النُّصوص بذكرِ الكتابِ السابقِ ، بالسَّعادة والشقاوة ، ففي " الصحيحين " عن عليِّ بن أبي طالب – وذكر الحديث - .
ففي هذا الحديث : أنَّ السعادة ، والشقاوة : قد سبقَ الكتابُ بهما ، وأنَّ ذلك مُقدَّرٌ بحسب الأعمال ، وأنَّ كلاًّ ميسر لما خُلق له من الأعمال التي هي سببٌ للسعادة ، أو الشقاوة .
وفي " الصحيحين " عن عمرانَ بن حُصينٍ ، قال : قال رجل :يا رسول الله ، أيُعرَفُ أهلُ الجَنَّةِ مِنْ أهلِ النَّارِ ؟ قالَ : ( نَعَمْ ) ، قالَ : فَلِمَ يعملُ العاملونَ ؟ قال : ( كلٌّ يعملُ لما خُلِقَ له ، أو لما ييسر له ) .
وقد روي هذا المعنى عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ كثيرةٍ ، وحديث ابن مسعود فيه أنَّ السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال .
" جامع العلوم والحِكَم " ( ص 55 ) . وينظر : " فتح الباري " ( 11 / 483 ) .
ثانياً:
ما يشير إليه السائل من الغنى أو الفقر ، والصحة أو المرض ... ، وسائر ما يصيب الناس من السراء والضراء في عيشهم ، وهو ما يعنيه بقوله : السعادة والشقاوة من المنظور الحسي : هذا كله قد سبق به الكتاب ، من قبل أن تخلق السموات والأرض ، وقد كتب أيضا فيما كتب للجنين من رزقه : ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ) القرآن/49 .
وإنما يُعرف المؤمن أنه محقق للإيمان في هذا الباب ، وأنه مسلِّم لقدَر الله تعالى ، مؤمن به : إذا شكر ربه في السرَّاء ، وصبر عند الضرَّاء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
جعل اللهُ سبحانَه وتعالى لعباده المؤمنين بكل منزلة خيراً منه ، فهم دائماً في نعمةٍ من ربهم ، أصابَهم ما يُحِبَّون ، أو ما يكرهون ، وجعل أقضيته ، وأقداره التي يقضيها لهم ، ويُقدرها عليهم : متاجرَ يَربحون بها عليه ، وطُرُقًا يصلون منها إليه ، كما ثبت في الصحيح عَن إمامهم ومتبوعهم - الذي إذا دُعي يوم القيامة كلُّ أناسٍ بإمامهم دُعُوا به صلواتُ الله وسلامه عليه - أنه قال : ( عجبًا لأمر المؤمن ، إن أمره كله عجب ، ما يقضي الله له من قضاء إلاّ كان خيراً له، إن أصابته سرَّاءُ شكَرَ فكان خيراً له ، وإن أصابَتْه ضرَّاءُ صَبَر فكان خيراً له).
فهذا الحديث يَعمُّ جميعَ أَقضيتِه لعبده المؤمن ، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها ، وشكرَ لمحبوبها ، بل هذا داخلٌ في مسمَّى الإيمان ، فإنه كما قال السلف : " الإيمان نصفان ، نصفٌ صبر ، ونصفٌ شكر " ، كقوله تعالى : ( إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ) ، وإذا اعتَبر العبدُ الدينَ كلَّه : رآه يَرجِعُ بجملته إلى الصبر ، والشكر .
" جامع المسائل " ( 1 / 165 ) .
فعلى المسلم أن يؤمن بقدر الله تعالى خيره وشرِّه ، ولا يسعه غير ذلك ؛ لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان ، والذي لا يصح من غيره .
وعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله ، ويسلِّم لما يكتبه الله له ، أو عليه ؛ فإن في ذلك حكَم بالغة ، ولا يتعجل في النظر لظاهر الأمر أنه نعمة ، أو نقمة ، بل العبرة بما يترتب على ذلك من شكر للنعم ، ومن رضى بالمصائب ، فهمنا يكون مؤمناً محققا لما طلبه الله منه ، ويكون مستفيداً من ذلك دوافع تدفعه للعمل وعدم القنوط واليأس ، كما تدفعه لشكر الله تعالى لنيل المزيد منها .
ثالثاً:
ثمة علامات يمكن للمسلم أن يستدل بها على كون أصحابها من أهل الجنة ، أو أهل النار ؛ وذلك بحسب اتصافه بها ، وتخلقه بأخلاقها ، ظاهراً وباطناً ، وعليه بوَّب الإمام النووي رحمه الله بقوله في " شرح مسلم " : " بَاب الصِّفَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ " ، وقد جعل تبويبه هذا على حديث عياض بن حمار المجاشعي ، والذي رواه مسلم ( 2265 ) ، وفيه :
( وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ .
قَالَ :
وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ ) .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
( ذو سلطان مقسط موفق ) وهذا هو الشاهد ، يعني : صاحب سلطان ، والسلطان يعم السلطة العليا ، وما دونها .
( مقسط ) أي : عادل بين مَن ولاَّه الله عليهم .
( موَّفق ) أي : مهتد لما فيه التوفيق والصلاح ، قد هدى إلى ما فيه الخير .
فهذا من أصحاب الجنة .
( ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ) رجل رحيم ، يرحم عبادَ الله ، يرحم الفقراء ، يرحم العجزة ، يرحم الصغار ، يرحم كل من يستحق الرحمة .
( رقيق القلب ) ليس قلبه قاسياً .
( لكل ذي قربى ومسلم ) وأما للكفار : فإنه غليظ عليهم .
هذا أيضاً من أهل الجنة : أن يكون الإنسان رقيق القلب ، يعني : فيه لين ، وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم .
والثالث : ( رجل عفيف متعفف ذو عيال ) يعني : أنه فقير ، ولكنه متعفف لا يسأل الناس شيئاً يحسبه الجاهل غنيّاً من التعفف .
( ذو عيال ) أي : أنه مع فقره عنده عائلة ، فتجده صابراً ، محتسباً ، يكد على نفسه ، فربما يأخذ الحبل ويحتطب ويأكل منه ، أو يأخذ المخلب يحتش فيأكل منه ، المهم : أنه عفيف ، متعفف ، ذو عيال ، ولكنه صابر على البلاء ، صابر على عياله ، فهذا من أهل الجنة ، نسأل الله أن يجعلنا من أحد هؤلاء الأصناف .
" شرح رياض الصالحين " ( 3 / 648 ، 649 ) .
وقال النووي – رحمه الله - :
شرح النووي على مسلم - (17 / 199)
( الضعيف الذي لا زَبر له الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ، ولا مالاً ) .
فقوله ( زبر ) بفتح الزاي وإسكان الموحدة ، أي : لا عقل له يزبره ، ويمنعه مما لا ينبغى ، وقيل : هو الذي لا مال له ، وقيل : الذي ليس عنده ما يعتمده .
وقوله ( لا يتبعون ) بالعين المهملة ، مخفف ، ومشدد ، من الاتباع ، وفي بعض النسخ " يبتغون " بالموحدة والغين المعجمة ، أي : لا يطلبون .
قوله صلى الله عليه و سلم ( والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة ) معنى ( لا يخفى ) : لا يظهر ، قال أهل اللغة : يقال خفيت الشيء إذا أظهرته ، وأخفيته إذا سترته وكتمته ، هذا هو المشهور ، وقيل : هما لغتان فيهما جميعاً .
قوله ( وذكر البخل والكذب ) هي في أكثر النسخ ( أو الكذب ) بـ ( أو ) ، وفي بعضها ( والكذب ) ، بالواو ، والأول : هو المشهور في نسخ بلادنا ، وقال القاضي : روايتنا عن جميع شيوخنا بالواو إلا ابن أبي جعفر عن الطبري فبـ ( أو ) وقال بعض الشيوخ : ولعله الصواب ، وبه تكون المذكورات خمسة .
وأما ( الشنظير ) فبكسر الشين والظاء المعجمتين وإسكان النون بينهما ، وفسَّره في الحديث بأنه الفحَّاش ، وهو السيء الخلق .
" شرح مسلم " ( 17 / 199 ، 200 ) .
فليتأمل العبد الموفق ، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل علامة أهل الجنة في الآخرة أن يعملوا بأعمالهم في الدنيا ، وجعل علامة أهل النار في الآخرة أن يعملوا بأعمالهم في الدنيا .
قال الإمام أحمد رحمه الله : " سمعت سفيان بن عيينة يقول : من يزرع خيرا يحصد غِبطة ، ومن يزرع شرا يحصد ندامة ؛ تفعلون السيئات وترجون أن تُجْزَوُا الحسنات ؟!
أجل ؛ كما يجني من الشوك العنب !! "
"العلل ومعرفة الرجال" (2/373) .
الغضب وإن كانت حقيقته جمرة تشعل النيران في القلب ، فتدفع صاحبها إلى قول أو فعل ما يندم عليه ، فهو عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قولٌ بالحق ، وغيرةٌ على محارم الله ، ودافعه دوماً إنكار لمنكر ، أو عتاب على ترك الأفضل .
والغضب له وظيفة كبيرة في الدفاع عن حرمات الله ودين الله ، وحقوق المسلمين وديارهم ، لكنه إذا ابتعد عن هدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تحول إلى شر وعداوة ، وخلافات وفرقة .
والغضب ينقسم إلى نوعين : غضب محمود وآخر مذموم ، ولكل منهما آثاره على النفس والمجتمع ، من سعادة أو شقاء ، وثواب أو عقاب .
فالغضب المذموم هو ما كان لأمر من أمور الدنيا ، وكان دافعه الانتصار للنفس ، أو العصبية والحميّة للآخرين .. وهذا الغضب تترتب عليه نتائج خطيرة على صاحبه وعلى مجتمعه ، ومن ثم حذرنا منه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وأوصانا بعدم الغضب في أحاديث كثيرة ، ومناسبات عِدَّة ، من ذلك : قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( ليس الشديد بِالصُّرَعَةِ ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) رواه البخاري . والصٌّرَعة: هو الذي يغلب الناس بقوته.
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : ( أن رجلاً قال للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أوصني ، قال : لا تغضب ، فردد مراراً ، قال : لا تغضب ) رواه البخاري ، وفي رواية ( لا تغضب ولك الجنة ) رواه الطبراني .
أما الغضب المحمود فهو ما كان يغضبه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لله ولحرماته ، ولم يكن لنفسه فيه نصيب ، وكان بسبب اعتداء على حرمة من حرمات الله ، أو قتل نفس مسلمة ، أو أخذ مال بغير حق ، وغيرها من المحرمات والمحظورات التي نُهِيَ عنها في دين الله ، ففي مثل هذه الحالات كان غضبه ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ( ما ضرب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ شيئا قط بيده ، ولا امرأة ولا خادما ، إلا أن يجاهد في سبيل الله ، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه ، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله ، فينتقم لله عز وجل ) رواه مسلم .
فلم يغضب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لنفسه أبدا ، يبين ذلك أنس ـ رضي الله عنه ـ فيقول : ( خدمت رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ عشر سنين ، لا والله ما سبني سبة قط ، ولا قال لي أف قط ، ولا قال لي لشيء فعلته لم فعلته ، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته ) رواه أحمد .
أما مواقفه ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي غضب فيها لله فهي كثيرة ، منها :
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أي في العفو عنها) ، فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فكلمه أسامة ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟!، ثم قام فاختطب فقال : أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) رواه مسلم .
ومن مواقفه ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي ظهر غضبه فيها ، حين بعث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ في سريّة ، فقام بقتل رجلٍ بعد أن نطق بالشهادة ، وكان يظنّ أنه إنما قالها خوفاً من القتل ، فبلغ ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فغضب غضباً شديداً ، وقال له : ( أقال : لا إله إلا الله وقتلته ؟!، قلت : يا رسول الله ، إنما قالها خوفا من السلاح ، قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟!، فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ ) رواه مسلم .
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ( دخل عليّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي البيت قرام (وهو الستر الرقيق) فيه صور ، فتلوّن وجهه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ثم تناول الستر فهتكه ، وقال : من أشد الناس عذابا يوم القيامة ، الذين يصوّرون هذه الصور ) رواه البخاري .
وشكا إليه رجل إطالة الإمام في صلاته ، ومشقة ذلك على المصلّين ، فغضب ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى قال أبو مسعود : " ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ " ، ثم قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( يا أيها الناس ، إن منكم لمنفرين ، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ) رواه أحمد .
بل كان يغضب ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمجرّد تباطؤ الناس عن الخير، فعن جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال : ( خطبنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فحثنا على الصدقة ، فأبطأ الناس ، حتى رؤى في وجهه الغضب ) رواه أحمد .
من هذه المواقف وغيرها يتبين لنا أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم كان يغضب ، وفي الوقت نفسه لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله ، أو تأخر الناس عن فعل الخير .. لا انتصار فيه للنفس ، ولا مدخل فيه للهوى أو حب الدنيا ..
ومن ثم فعلى المسلم أن يتجنب أسباب الغضب ودواعيه ، من الحقد والحسد ، والحرص على الدنيا ، والجدال والخلاف .. وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أحاديث كثيرة .
هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الغضب :
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، فالشيطان الذي أخرج آدم ـ عليه السلام ـ من الجنة ، ودفع قابيل لقتل هابيل ، هو نفسه الذي يثير الغضب ، فلا يترك الإنسان حتى ينساق له ويتمثل لأمره ، لذا أرشدنا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند الغضب ، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم .
عن سليمان بن صرد قال : ( استب رجلان عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه (العروق المحيطة بعنقه) ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) رواه مسلم .
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله ، سكن غضبه ) .
ومن وصايا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للغاضب : أن يغير مكانه ، فإذا كان واقفًا فليجلس أو يضطجع ، فعن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ( إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ) رواه أبو داود .
وفي ذلك علاج لتهدئة النفس ، وإخماد نار غضبها ، لأن الإنسان في حالة الوقوف يكون مهيئًا للانتقام أكثر منها في حالة الجلوس ، وفي حالة الجلوس منها في حالة الاضطجاع ، لذا جاء الوصف النبوي بهذه الوصفة الدقيقة ، التي أكدتها الدراسات النفسية المعاصرة .
السكوت وضبط اللسان هدي ودواء نبوي لعلاج الغضب ، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( علِّموا ، ويسِّروا ولا تعسّروا ، وإذا غضب أحدكم فليسكت ، قالها ثلاثًا ) رواه أحمد .
فإطلاق اللسان أثناء الغضب قد يجعل الإنسان يتلفظ بكلمات يندم عليها بعدها ، ومن ثم أوصى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الغاضب بالسكوت ، وأوصى المسلم بوجه عام بقول الخير أو الصمت ، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيرا أو ليصمت ) رواه مسلم .
ومن هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الغضب كظمه بالحلم والعفو ، ولا شك أن ذلك يفتح أبواب المحبة والتسامح بين الناس ، ويسد أبواب الشيطان التي يمكن من خلالها أن يدخل بين المسلمين ، فيثير العداوات والبغضاء في صفوفهم ، بل ويرتقي بالغاضب إلى الإحسان إلى من أساء إليه .
وهديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ القولي والفعلي في عدم الغضب وكظم الغيظ والعفو كثير، من ذلك :
قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( من كظم غيظًا وهو يستطيع أن ينفذه ، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيِّره أي الحور شاء ) رواه ابن ماجه .
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ) رواه مسلم .
فهذه الأحاديث وغيرها تحث المسلم على عدم الغضب ، بل على العفو والتسامح ، والابتعاد عن الانتقام ، وتبين الأجر العظيم لذلك في الدنيا والآخرة .
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : ( كنت أمشي مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعليه بُرد نجراني غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابي ، فجبذه بردائه جبذة شديدة ، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أثّرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ، ثم قال : يا محمد ، مُرْ لي من مال الله الذي عندك ، فالتفت إليه فضحك ، ثم أمر له بعطاء ) رواه البخاري .
هكذا كان هدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فهو أَمْلَكُ الناس لنفسه في مواطن الغضب ، إلا أن تُنتهك حرمات الله تعالى ، فعندها يغضب ، فما أحوجنا للامتثال بهديه صلى الله عليه وسلم ، في الرضا والغضب ، بل في حياته كلها .

منتديات عرب مسلم | منتدى برامج نت | منتدى عرب مسلم | منتديات برامج نت | منتدى المشاغب | منتدى فتكات | منتديات مثقف دوت كوم | منتديات العرب | إعلانات مبوبة مجانية | إعلانات مجانية | اعلانات مبوبة مجانية | اعلانات مجانية | القرآن الكريم | القرآن الكريم قراءة واستماع | المكتبة الصوتية للقران الكريم mp3 | مكتبة القران الكريم mp3 | ترجمة القرآن | القرآن مع الترجمة | أفضل ترجمة للقرآن الكريم | ترجمة القرآن الكريم | Quran Translation | Quran with Translation | Best Quran Translation | Quran Translation Transliteration | تبادل إعلاني مجاني