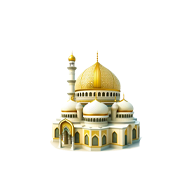حب الرسول - صلى الله عليه وسلم - تابع لحب الله تعالى ، ولازم من لوازمه ؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبيب ربه سبحانه ، ولأنه المبلغ عن أمره
ونهيه ، فمن أحب الله تعالى أحب حبيبه - صلى الله عليه وسلم - وأحب أمره
الذي جاء به ؛ لأنه أمر الله تعالى . ثم
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يُحب لكماله، فهو أكمل الخلق والنفس تحب
الكمال ، ثم هو أعظم الخلق - صلى الله عليه وسلم - فضلاً علينا وإحسانـًا
إلينا ، والنفس تحب من أحسن إليها ، ولا إحسان أعظم من أنه أخرجنا من
الظلمات إلى النور ، ولذا فهو أولى بنا من أنفسنا ، بل وأحب إلينا منها .
هو حبيب الله ومحبوبه .. هو أول المسلمين ، وأمير الأنبياء ، وأفضل الرسل ، وخاتم المرسلين .. - صلوات الله تعالى عليه - .
هو الذي جاهد وجالد وكافح ونافح حتى مكّن للعقيدة السليمة النقية أن تستقر
في أرض الإيمان ونشر دين الله تعالى في دنيا الناس ، وأخذ بيد الخلق إلى
الخالق - صلى الله عليه وسلم - .
هو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وجمّله وكمّله : (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ
عَظِيمٍ) (القلم/4) ، وعلمه : (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً)(النساء/113) وبعد أن رباه
اجتباه واصطفاه وبعثه للناس رحمة مهداة : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)(الأنبياء/107) ، وكان مبعثه - صلى الله عليه وسلم
- نعمة ومنّة : (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ )(آل عمران/164) .
هو للمؤمنين شفيع ، وعلى المؤمنين حريص ، وبالمؤمنين رؤوف رحيم : (لَقَدْ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)(التوبة/128) - صلى
الله عليه وسلم - .
على يديه كمل الدين ، وبه ختمت الرسالات - صلى الله عليه وسلم - .
هو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الإنسانية والسلام والإسلام محمد بن عبد
الله عليه أفضل صلاة وسلام ، اختصه الله تعالى بالشفاعة ، وأعطاه الكوثر ،
وصلى الله تعالى عليه هو وملائكته : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ
يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(الأحزاب/56) صلى الله عليك يا سيدي يا
حبيب الله ، يا رسول الله ، يا ابن عبد الله ورسول الله .
هو الداعية إلى الله ، الموصل لله في طريق الله ، هو المبلغ عن الله ، والمرشد إليه، والمبيّن لكتابه والمظهر لشريعته .
ومتابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من حبّ الله تعالى فلا يكون
محبـًّا لله عز وجل إلا من اتبع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛
لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يأمر إلا بما يحب الله تعالى ، ولا
يخبر إلا بما يحب الله عز وجل ، التصديق به ، فمن كان محبـًا لله تعالى
لزمَ أن يتبع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيصدقه فيما أخبر ويتأسَّى به -
صلى الله عليه وسلم - فيما فعل ، وبهذا الاتباع يصل المؤمن إلى كمال
الإيمان وتمامه ، ويصل إلى محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وهل محبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا من محبة الله تعالى ؟! وهل
طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا من طاعة الله عز وجل ؟! : (قُلْ
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(آل عمران/31) .
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الشريفة : " إن هذه الآية الكريمة حاكمة
على من ادعى محبة الله تعالى وليس هو على الطريقة المحمدية ، فإنه كاذب في
دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله
وأفعاله ، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)) ولهذا قال الله تعالى : (قُلْ
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) أي
يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول
كما قال بعض الحكماء : ليس الشأن أن تحب ، إنما الشـأن أن تُحبَّ .
وحبّ سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
يقول - عليه الصلاة والسلام - : ((من أحب سنتي فقد أحبني ، ومن أحبني كان معي في الجنة)) .
وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها مكانتها ومنزلتها ، فرتبتها
تلي رتبة القرآن الكريم ، فهي في المنزلة الثانية بعد كتاب الله عز وجل ،
توضح القرآن الكريم وتفسره وتبين أسراره وأحكامه ، وكثير من آيات القرآن
الكريم جاءت مجملة، أو عامة ، أو مطلقة ، فجاءت أقوال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - وأعماله كاشفة للمراد الإلهي وموضحة له عندما فصّلت المجمل ،
أو قيدت المطلق ، أو خصصت العام : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )(النحل/44) .
وهي الينبوع الثاني من ينابيع الشريعة الإسلامية .
هي
المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله عز وجل : (لَقَدْ مَنَّ
اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ)(آل عمران/164) والحكمة هنا : السُّنَّة .
ولقد أمرنا المولى سبحانه باتباعها ونهانا عن مخالفتها : (وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)(الحشر/7) ليس
لنا إلا التسليم المطلق بها والإذعان لأحكامها : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم)(الأحزاب/36) .
كما جعل سبحانه التسليم بها دلالة وعلامة على الإيمان الحق الصادق : (فَلا
وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيماً)(النساء/65) .
وهي حجة في التشريع ؛ لأنها وحي يوحى : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى)(النجم/3 ، 4) .
من أجل ذلك كانت أقواله وأعماله - صلى الله عليه وسلم - بوصفه رسولاً - داخلة في نطاق التشريع .
وما
دامت أحكامه صادرة عن طريق الله تعالى : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ )(النساء/105) ، وما دام هو مهدي إلى صراط الله
تعالى وهو يهدي إلى صراط الله عز وجل ، فعلى الناس الائتمار بأمره ،
والابتعاد عن نهيه : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا)(الحشر/7) .
فإذا كان الأمر كذلك ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو : كيف نحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟
إن حبه - صلى الله عليه وسلم - يكون بتعظيمه وتوقيره واتباع سنته والدفاع
عنها ونصرة دينه الذي جاء به ، وبمعنى آخر أن نحبه كما أحبه أصحابه - رضوان
الله عليهم - .
فمن المعلوم أن المجتمع المكي كان مجتمعـًا كافرًا فجاءه النور المبين -
صلى الله عليه وسلم - ، فدعا إلى الله سبحانه ، ولقي ما لاقى من الصد
والإعراض والأذى ، وأبى أكثر الناس إلا كفورا ، وفتح الله سبحانه بعض
القلوب لهذه الدعوة الخالدة ، ولهذا النور المبين ، فدخلت مجموعة بسيطة في
دين الله سبحانه ، فكيف كان الحب بينهم ؟
لقد بدأ هذا الحب بينهم وبين من أخرجهم الله تعالى به من الظلمات إلى النور، بينهم وبين محمد - صلى الله عليه وسلم - .
فهذه زوجه خديجة - رضي الله عنها - ومنذ اللحظة الأولى التي أبلغها فيها
بنزول الوحي ، هاهي تدفع - رضي الله عنها - عنه ، وتثبت فؤاده بكلمات تبدو
فيها المحبة ، جلية ، إذ تقول : " كلا والله ، ما يخزيك الله أبدًا ، إنك
لتصل الرحم ، وتحمل الكلَّ ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على
نوائب الدهر " .
ولئن كانت هذه زوجه ، فانظر ما فعل أبو بكر - رضي الله عنه - يوم وقف في
قريش خطيبـًا يدعوهم إلى الإسلام ، وما زال المسلمون في المرحلة السرية
للدعوة، وعددهم قليل ، فقام إليهم المشركون يضربونهم ضربـًا شديدًا ، وضرب
أبو بكر - رضي الله عنه - حتى صار لا يعرف أنفه من وجهه ، فجاء قومه بنو
تيم فأجلوا المشركين عنه وأدخلوه منزله وهم لا يشكون في موته - رضي الله
عنه - ، وبقي أبو بكر - رضي الله عنه - في غشية لا يتكلم حتى آخر النهار ،
فلما أفاق كان أول ما تكلم به : " ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
؟ " فلامه الناس .
لاموه على أن يذكر محمدًا - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا الموقف الذي يفترضون فيه أن يذكر نفسه ، وأن يتحسر على حاله .
لاموه
فما أبه لهم ، وصار يكرر ذلك ، فقالت أمه : " والله ما لي علم بصاحبك محمد
" ، فقال : " اذهبي إلى أم جميل فاسأليها عنه " ، وكانت أم جميل امرأة
مسلمة ، فلما سألتها أم أبي بكر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه
وسلم - قالت أم جميل حُبًّا لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وحرصـًا عليه : "
لا أعرف محمدًا ، ولا أبا بكر " ثم قالت : " تريدين أن أخرج معك ؟ " قالت :
" نعم " ، فخرجت معها إلى أن جاءت أبا بكر - رضي الله عنه - فوجدته
صريعـًا ، فصاحت وقالت : " إن قومـًا نالوا هذا منك لأهل فسق ، وإني لأرجو
أن ينتقم الله منهم " فقال لها أبو بكر - رضي الله عنه - : " ما فعل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ " فقالت له : هذه أمك تسمع " ، قال - رضي
الله عنه - : " فلا عين عليك منها " - أي أنها لن تفشي سرك - فقالت : "
سالم هو في دار الأرقم " فقال - رضي الله عنه - : " والله لا أذوق طعامـًا
ولا أشرب شرابـًا أو آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فقالت أمه :
فأمهلناه حتى إذا هدأت الرِّجل وسكن الناس خرجنا به يتكئ عليَّ ، حتى دخل
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرقّ له رقّة شديدة ، وأكب عليه
يقبله ، وأكب عليه المسلمون كذلك، فقال أبو بكر - رضي الله عنه - : " بأبي
أنت وأمي يا رسول الله ، ما بي من بأس إلا ما نال الناس من وجهي ، وهذه أمي
برَّةٌ بولدها فعسى الله أن يستنقذها بك من النار " ، فدعا لها رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - ودعاها إلى الإسلام فأسلمت.
أيُّ حبٍ تكنه يا أبا بكر لصاحبك ؟! أما انشغلت بنفسك وجراحك ووجهك الذي
تغيرت معالمه ؟ لو شغلتك آلامك لما لامك أحد من العالمين ، ولكن ماذا تصنع
بحب ملك عليك كل جوارحك ؟
إنه يحب في محمد - صلى الله عليه وسلم - الخُلق الذي طالما امتدحوه به قائلين : هذا الصادق الأمين .
إنه يحب فيه الخُلق الحسن ، والرأي السديد ، والعشرة الطيبة ، وكل ذلك قد
خبره محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وهو اليوم يحب فيه إلى جانب ذلك كله
النبي - صلى الله عليه وسلم - .
أما خبر سعد بن الربيع - رضي الله عنه - فعجيب ، حيث سأل النبي - صلى الله
عليه وسلم - : ((أفي الأحياء سعد أم في الأموات ؟)) فخرج أُبيّ بن كعب -
رضي الله عنه - يستطلع الخبر ، فوجده في الرمق الأخير ، فقال سعد : " بل
أنا في الأموات ، فأبلِغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عني السلام ،
وقل له : إن سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنَّا خيرًا ، ما جزى
نبيـًا عن أمته " ، ثم قال لأبي : " وأبلغ قومك عني السلام ، وقل لهم : إن
سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى نبيكم - صلى
الله عليه وسلم - وفيكم عين تطرف " ، ثم لم يبرح أن مات ، فجاء أبي بن كعب -
رضي الله عنه - النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر ، فقال - صلى
الله عليه وسلم - : ((رحمه الله ، نصح لله والرسول حيـًا وميتـًا)) .
ومن حب الأنصار لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رواه ابن هشام في
سيرته من أنه مر - صلى الله عليه وسلم - بدار من دور الأنصار من بني عبد
الأشهل وظفر ، فسمع البكاء والنواح على قتلاهم ، فذرفت عينا رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فبكى ، ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : ((لكن حمزة
لا بواكي له ! )) فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير - رضي الله عنهما -
إلى دار عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتحزمن ، ثم يذهبن فيبكين على عم رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فلما سمع بكاءهن على حمزة - رضي الله عنه -
خرج - صلى الله عليه وسلم - عليهنَّ وهنَّ على باب المسجد يبكين عليه ،
فقال : ((ارجعن يرحمكنَّ الله ، فقد آسيتن - عزيتن وعاونتن - بأنفسكنَّ)) ،
وفي رواية أنه قال - صلى الله عليه وسلم - لما سمع بكاءهنَّ : ((رحم الله
الأنصار ، فإن المواساة منهم ما علمت لقديمة، مروهنَّ فلينصرفن)) .
ومما يذكر أيضـًا من هذا الحب الذي لا نهاية له حكاية تلك المرأة من بني
دينار ، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بأُحد ، فلما نُعُوا لها قالت : " فما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- ؟ " قالوا : " خيرًا يا أم فلان ، هو بحمد الله كما تحبين " ، قالت : "
أرونيه حتى أنظر إليه " ، فأشير لها إليه ، حتى إذا رأته قالت : " كل مصيبة
بعدك جلل " - أي صغيرة- .
مقابلة الحب بالحب
وبما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودينه الذي جاء به هو مصدر هذا الحب
، فمن البداهة أن نرى حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه ، وكيف
بادلهم حبـًا بحب ، ومودة بمودة ، وسأسوق في ذلك حادثة كلما ذكرتها أو
قرأتها أعظمت المحب والمحبوب .
كان ذلك عقب غزوة حنين ، حيث حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - في توزيعه
للغنائم على أن يتألف بها من دخل في الإسلام من أهل مكة وقبائل العرب ،
ولذا فقد كانت معظم الغنائم بينهم ، إن لم تكن كلها ، ولم يجعل النبي - صلى
الله عليه وسلم - فيها للأنصار نصيبـًا ، فوجد هذا الحي من الأنصار في
أنفسهم ، حتى كثرت فيهم القالة ، حتى قال قائلهم : لقي والله رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - قومه ، فدخل عليه سعد بن عبادة - رضي الله عنه - من
الأنصار ، فقال : " يا رسول الله ، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك
في أنفسهم ، لما فعلت في هذا الفيء الذي أصبت ، قسّمت في قومك ، وأعطيت
عطايا عظاما في قبائل العرب ، ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء " ،
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((فأين أنتَ من ذلك يا سعد ؟ )) ،
قال : " يا رسول الله ، ما أنا إلا من قومي " ، فقال - صلى الله عليه وسلم
- : ((فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة)) فلما اجتمعوا أتاهم رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال :
((يا معشر الأنصار : مقالة بلغتني عنكم ، وجِدَةَ عتاب وجدتموها عليَّ في
أنفسكم ؟ ألم آتِكم ضُلالاً فهداكم الله ، وعالة - فقراء - فأغناكم الله ،
وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟)) قالوا : " بلى ، الله ورسول الله أمن -
أكثر نعمة - وأفضل " ، ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : ((ألا تجيبونني يا
معشر الأنصار ؟)) قالوا : " بم نجيبك يا رسول الله ؟ لله ورسوله المنّ
والفضل " ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : ((أما والله لو شئتم لقلتم
فلصَدقتم ولصُدِّقتم : أتيتنا مكذبـًا فصدقناك ، ومخذولاً فنصرناك ،
وطريدًا فآويناك ، وعائلاً فآسيناك ، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم
فيَّ لعاعة - بقلة خضراء ناعمة - من الدنيا تألفت بها قومـًا ليسلموا ،
ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة
والبعير ، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ، ولو سلك الناس شعبـًا - طريقـًا بين جبلين -
وسلكت الأنصار شعبـًا لسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار ، وأبناء
الأنصار ، وأبناء أبناء الأنصار)) ، فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم - بلوها
بالدموع - وقالوا : " رضينا برسول الله قسمـًا وحظـًا " .
ولئن كان هذا مع الأنصار عامة ، فقد كان مع بعض المسلمين ، فقد قال أحد
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يا رسول الله ، أعطيت عيينة بن حصن
والأقرع بن حابس مائة مائة ، وتركت جعيل بن سراقة الضمري " ، فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - : ((أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة
خير من طلاع الأرض - ما يملأها حتى يطلع عنها ويسيل - كلهم مثل عيينة بن
حصن والأقرع بن حابس ، ولكني تألَّفتهما ليسلما ، ووكلت جعيل بن سراقة إلى
إسلامه)) .
ألا ما أعظم محمدًا - صلى الله عليه وسلم - حبيبـًا محبوبـًا ، وما أعظمه
محبـًا يضع الأمور في نصابها ، ويعطي كل ذي حقٍ حقه وكل ذي قدرٍ قَدْرَه -
صلى الله عليه وسلم - .
علم صحبه الكرام - رضوان الله عليهم - الحب بحبه لهم فأحبوه ، وكان هذا
الحب منهم علامة إيمانهم ، وشعلة عقيدتهم ، وطريقهم لرضوان ربهم .