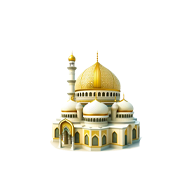الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وسائر الصالحين.
أما بعد: فلما كان توحيد الله عز وجل والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام، أهم الواجبات وأعظم الفرائض، والعلم بذلك أشرف العلوم وأفضلها، ولما كانت الحاجة إلى هذا الأصل الأصيل داعية إلى بيانه بالتفصيل رأيت إيضاح ذلك في هذه الكلمة الموجزة لشدة الحاجة إلى ذلك، ولأن هذا الموضوع العظيم جدير بالعناية، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لإصابة الحق في القول والعمل، وأن يعيذنا جميعا من الخطأ والزلل. فأقول ومن الله سبحانه وتعالى أستمد العون والتوفيق: لا ريب أن التوحيد هو أهم الواجبات، وهو أول فريضة، وهو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو زبدة هذه الدعوة كما بين ذلك ربنا عز وجل في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين، حيث يقول سبحانه عن جميع المرسلين: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ[1].
أوضح جل وعلا أنه بعث في جميع الأمم في كل أمة رسولاً يقول لهم: اعبدوا الله، واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل كل واحد يقول لقومه وأمته: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
المعنى: وحدوا الله؛ لأن الخصومة بين الرسل والأمم في توحيد العبادة، وإلا فالأمم تقر بأن الله ربها وخالقها ورازقها، وتعرف كثيرا من أسمائه وصفاته، ولكن النزاع والخصومة، من عهد نوح إلى يومنا هذا في توحيد الله بالعبادة، فالرسل تقول للناس: أخلصوا العبادة له، وحدوه بها، واتركوا عبادة ما سواه، وأعداؤهم وخصومهم يقولون: لا بل نعبده ونعبد غيره، ما نخصه بالعبادة.
هذا هو محل النزاع بين الرسل والأمم. الأمم لا تنكر عبادته بالجملة، بل تعبده، ولكن النزاع هل يخص بها أم لا يخص؟ فالرسل بعثهم الله لتخصيص الرب بالعبادة، وتوحيده بها، دون كل ما سواه، لكونه عز وجل المالك، القادر على كل شيء، الخلاق، الرزاق للعباد، العليم بأحوالهم، إلى غير ذلك. فلهذا دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع الأمم، إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وترك عبادة ما سواه. وهذا هو معنى قوله عز وجل: أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ[2] قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى: العبادة هي التوحيد.
وهكذا قال جميع العلماء: إن العبادة هي التوحيد. إذ هو المقصود، والأمم الكافرة تعبد الله وتعبد معه سواه، كما قال جل وعلا: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ[3] فتبرأ من معبوداتهم كلها إلا فاطره سبحانه، أي خالقه. فعلم أنهم يعبدونه، ويعبدون معه غيره. فلهذا تبرأ الخليل من معبوداتهم سوى خالقه وفاطره عز وجل، وهو الله سبحانه وتعالى، وهكذا قوله عز وجل: وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي[4] فعلم أنهم يعبدون الله، ويعبدون معه غيره. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فعلمنا بذلك أن المقصود من دعوة الرسل تخصيص الله بالعبادة، وإفراده بها، لا يدعى إلا هو جل وعلا، ولا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يُصلى إلا له، إلى غير ذلك من العبادات، فهو المستحق لها جل وعلا دون كل ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله.
هذا هو معناها عند أهل العلم؛ لأن الآلهة موجودة بكثرة والمشركون من قديم الزمان: من عهد نوح يعبدون آلهة من دون الله منها: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، وغير ذلك.
وهكذا العرب عندها آلهة كثيرة. وهكذا الفرس والروم وغيرهم كلهم عندهم آلهة يعبدونها مع الله. فعلم بذلك أن المقصود بقول: لا إله إلا الله هو المقصود بدعوة الرسل، وهو أن يوحد الله، ويخص بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا، ولهذا يقول سبحانه في كتابه المبين: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ[5] فاتضح بذلك أن المقصود تخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، وأنه سبحانه المعبود الحق جل وعلا، وأن ما عبد من دونه معبود باطل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ[6] أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اتركوا عبادة الطاغوت، وابتعدوا عنها.
والطاغوت: كل ما عبد من دون الله من الإنس والجن والملائكة، وغير ذلك من الجمادات، ما لم يكن يكره ذلك ولا يرضى به. والمقصود أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله من الجمادات وغيرها، ممن يرضى بذلك، أما من لا يرضى بذلك كالملائكة والأنبياء والصالحين، فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم، وزينها للناس.
فالرسل والأنبياء والملائكة، وكل صالح لا يرضى أن يعبد من دون الله أبداً، بل ينكر ذلك ويحاربه، فليس بطاغوت، وإنما الطاغوت كل ما عبد من دون الله ممن يرضى بذلك كفرعون وإبليس وأشباههما ممن يدعو إلى ذلك، أو يرضى به.
وهكذا الجمادات من الأشجار والأحجار والأصنام المعبودة من دون الله، كلها تسمى طاغوتا بسبب عبادتها من دون الله. وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ[7] وهذه الآية مثل الآية السابقة، يبين فيها سبحانه أن دعوة الرسل جميعا هي الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده جل وعلا دون كل ما سواه، ولو كان قوله لا إله إلا الله يكفي مع قطع النظر عن تخصيص الله بالعبادة والإيمان بأنه هو المستحق لها، لما امتنع الناس من ذلك، ولكن المشركين عرفوا أن قولها يبطل آلهتهم، وأن قولها يقتضي أن الله هو المعبود الحق، والمختص بذلك جل وعلا. فلهذا أنكروها وعادوها واستكبروا عن الاستجابة لها فاتضح بهذا أن المقصود من ذلك تخصيص الله بالعبادة، وإفراده بها دون جميع ما عبد من دونه سبحانه وتعالى، من أنبياء أو ملائكة أو صالحين أو جن أو غير ذلك؛ لأن الله سبحانه هو المالك الرازق القادر المحيي المميت الخالق لكل شيء المدبر لأمور العباد، فهو المستحق لأن يعبد جل وعلا، وهو العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى، فلذلك بعث الرسل لدعوة الخلق إلى توحيده والإخلاص له، ولبيان أسمائه وصفاته، وأنه المستحق لأن يعبد ويعظم لكمال علمه، وكمال قدرته، وكمال أسمائه وصفاته، ولأنه عز وجل النافع الضار، العالم بأحوال عباده السميع لدعائهم، الكفيل بمصالحهم جل وعلا، فهو المستحق لأن يعبد جل وعلا دون ما سواه سبحانه وتعالى، وقد أخبر سبحانه عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لقومهم: اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ[8] فهذا مطابق لقوله تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ[9].
وقد أجاب قوم هود نبيهم عليه الصلاة والسلام بقولهم: أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا[10] فقد علموا المعنى وعرفوه، وهو أن دعوة هود عليه الصلاة والسلام تقتضي إخلاص العبادة لله وحده وخلع الأوثان المعبودة من دونه، ولهذا قالوا: أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ[11] فاستمروا على العناد والتكذيب، حتى نزل بهم العذاب نسأل الله العافية.
والله سبحانه أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعبد وحده لا شريك له، وليبين حقه لعباده، ويذكر للعباد ما هو موصوف به سبحانه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ليعرفوه جل وعلا بأسمائه وصفاته وعظيم إحسانه، وكمال قدرته، وإحاطة علمه جل وعلا، وما ذاك إلا لأن توحيد الربوبية هو الأساس والأصل لتوحيد الإلهية والعبادة، فلهذا بعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب السماوية من الله عز وجل لبيان صفاته وأسمائه وعظيم إحسانه، وبيان استحقاقه أن يعظم ويدعى ويسأل جل وعلا، حتى تخضع الأمم لعبادته وطاعته، وحتى تنيب إليه، وحتى تعبده دون كل ما سواه جل وعلا، وهذا موجود كثيرا في كتاب الله عز وجل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن كثير من رسله عليهم الصلاة والسلام فقال سبحانه: قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ[12] وقال جل وعلا: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ * فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ[13]، فبين عليه الصلاة والسلام أنه معتمد على الله وأنه متوكل عليه جل وعلا، وأنه لا يبالي بتهديدهم وتخويفهم، وأنه لا بد له من تبليغ رسالات الله، فقد بلغ فعلا عليه الصلاة والسلام، فعرفهم بقدرة ربه وعظمته، وأنه هو المحيط بالجميع، والقادر على إنجائه، وعلى إهلاك أعدائه، كما أنه القادر على حفظ رسله وأنبيائه، وإحاطتهم بكلاءته، وإعانتهم على تنفيذ ما جاءوا به من الهدى، وأنزل في هذا سورة تتعلق بنوح عليه الصلاة والسلام حيث قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ * يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا * فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا * مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا[14].
فأوضح سبحانه على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام شيئا من صفاته عز وجل، وأنه الذي يمدهم بما يمدهم به من الأرزاق والخير الكثير، والنعم العظيمة، وأنه المستحق لأن يعبد ويطاع، ويعظم جل وعلا.
وقال عن هود عليه الصلاة والسلام، وعن قومه في سورة الشعراء: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تعبثون * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ * وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ[15]. فأوضح الله جل وعلا على لسان نبيهم هود عليه الصلاة والسلام كثيرا من النعم التي أنعم بها عليهم جل وعلا، وأنه رب الجميع، وأن الواجب عليهم الخضوع له وطاعة رسوله وتصديقه، ولكنهم أبوا واستكبروا فنزل بهم عذاب الله من الريح العقيم.
وقال عن صالح عليه السلام: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ * وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ[16] الآيات. فبين صالح عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالله، وأنه رب العالمين، وأنه أعطاهم ما أعطاهم من النعم.
فكان الواجب عليهم الرجوع إليه وتصديق رسوله صالح، وطاعته فيما جاء به، وأن لا يطيعوا المسرفين المفسدين في الأرض، ولكنهم لم يبالوا بهذه النصيحة، ولم يبالوا بهذا التوجيه، بل استمروا في عنادهم وضلالهم وكفرهم حتى أهلكهم الله بالصيحة والرجفة، نسأل الله العافية.
وذكر سبحانه وتعالى أيضا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيئا من صفاته عز وجل، وأنه ذكرها لقومه لينيبوا إلى الله وليعبدوه ويعظموه حيث قال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ[17].
ينبغي الوقفة عند هذا فإن الله سبحانه بهذا يبين لهم أن هذه الأصنام لا تصلح للعبادة، لأنها لا تسمع ولا تجيب الداعي، ولا تنفع ولا تضر؛ لأنها جماد لا إحساس لها بحاجة الداعين وسؤالهم وما لديهم من ضرورات، فكيف تدعى من دون الله، فلهذا قال: هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ[18] ماذا أجابوا؟ حاروا وحادوا عن الجواب؛ لأنهم يعلمون أن هذه الآلهة ليس عندها نفع ولا ضر، وليست تسمع دعاء الداعين ولا تجيبه.
فلهذا قالوا: بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ[19] ولم يقولوا إنهم يسمعون أو ينفعون أو يضرون. بل حادوا عن الجواب وأتوا بجواب يدل على الحيرة والشك، بل والاعتراف بأن هذه الآلهة لا تصلح للعبادة، فقالوا: بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ[20] يعني سرنا على طريقتهم وسبيلهم من غير نظر فيما قلت لنا. وهذا معنى قوله في الآية الأخرى: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ[21] هذه طريقتهم الملعونة الخبيثة التي سلكوها واحتجوا بها، وساروا عليها، نسأل الله السلامة، ثم قال لهم الخليل عليه السلام: قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ[22] مراده بذلك معبوداتهم من الأصنام. ولهذا قال: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ[23] فقوله: إلا رب العالمين، يدلنا على أنه كان عليه الصلاة والسلام، يعلم أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولهذا استثنى ربه، فقال: إلا رب العالمين، كما في الآية الأخرى: إِلا الَّذِي فَطَرَنِي[24] فعلم بذلك أن المشركين يعبدون الله، ويعبدون معه سواه، ولكن النزاع بينهم وبين الرسل في تخصيص الله بالعبادة، وإفراده بها دون كل ما سواه جل وعلا.
ثم قال بعد ذلك في بيان صفات الرب: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ[25]. هذه أفعال الرب جل وعلا: يشفي المرضى ويميت ويحيي، ويطعم ويسقي، ويهدي من يشاء، وهو الخلاق القادر على مغفرة الذنوب وستر العيوب فلهذا استحق العبادة على عباده جل وعلا، وبطلت عبادة كل ما سواه، لأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يعلمون المغيبات ولا يستطيعون لداعيهم أن يقدموا شيئا نفعاً أو ضراً، كما قال سبحانه: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ[26] فبين عجزهم، وبين أن دعوتهم من دون الله شرك بالله عز وجل، ولهذا قال: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ[27] فبين سبحانه عجز هذه الآلهة جميعها، وبين أنهم بهذا الدعاء قد أشركوا بالله عز وجل.
وهنا قال: وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ[28] يعني أطمع أنه سبحانه يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهو جل وعلا ينفع في الدنيا، وينجي في الآخرة، أما هذه الأصنام فلا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل تضر، ولهذا قال عن خليله إبراهيم: وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ * رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ * وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ[29] هذا كله يدل على الإيمان بالآخرة والدعوة إلى ذلك، وتنبيه العباد على أن هناك آخرة لا بد من المصير إليها، وهناك جزاء وحساباً، ولهذا قال بعده: وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ * وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ[30] دعا له بالمغفرة قبل أن يعلم حاله، فلما علم حاله تبرأ منه، كما قال في سورة العنكبوت: وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ ترجعون[31] فبين عليه الصلاة والسلام أن العبادة حق الله، وأنه يجب أن يتقى ويعبد سبحانه وتعالى، وأن الذي فعلوه إفك لا أساس له، وأن معبوداتهم لا تملك لهم رزقاً أبداً، كما أنها لا تنفعهم ولا تضرهم فهي أيضا لا تملك لهم رزقاً، بل الله جل وعلا هو الرزاق، ولهذا قال: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ[32] فهو سبحانه الذي يعبد ويطلب الرزق منه جل وعلا، دون كل ما سواه سبحانه وتعالى، وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ[33] فالمرجع إليه وهو سبحانه المالك لكل شيء، والقادر على كل شيء، والمستحق لأن يشكر لكمال إنعامه وإحسانه، وهو الذي يطلب منه الرزق جل وعلا، ولهذا قال في آيات أخرى: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ[34]، وقال عز وجل: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ[35]، والآيات الدالة على أن الله سبحانه أمر الرسل أن يوجهوا العباد إليه وأن يعرفوهم بخالقهم ورازقهم وإلههم سبحانه كثيرة جدا، موجودة في كتاب الله، من تأمل القرآن وجد ذلك واضحاً بيِّنا، فالرسل أفصح الناس وأعرف الناس بالله عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم نشاطاً في الدعوة إليه، فليس هناك من هو أصبر منهم على الدعوة ولا أعلم منهم بالله، ولا أحب لهداية الأمم منهم عليهم الصلاة والسلام. ولهذا بلغوا رسالات الله أكمل تبليغ وأتمه، وبينوا للناس صفات الخالق المعبود وأسماءه سبحانه وأفعاله، وفصلوها كي يعلم العباد ربهم، وحتى يعرفوه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده، وحتى ينيبوا إليه عن بصيرة وعلم.
ومن هذا ما ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ * وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ * وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ * قَالَ كَلا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ * فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ[36]، أمره أن يبين له أنه رسول رب العالمين، لعله يتذكر فينيب إلى الحق لكنه لم يتذكر بل أعرض عن ذلك وقال: أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ * وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ * قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ * فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ * وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ * قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ * قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ * قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ * قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ * قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ[37].
فانظروا كيف يبين له موسى عليه الصلاة والسلام صفات الرب عز وجل، وأنه رب العالمين ورب السموات ورب الأرض وما بينهما، ورب الخلائق كلها ورب المشرق والمغرب، حتى يعلم عدو الله هذه الصفات لعله يرجع إلى الحق والصواب، ولكن سبق في علم الله أنه يستمر على طغيانه وضلاله ويموت على كفره وعناده، نسأل الله العافية.
وبين الله سبحانه وتعالى لهارون وموسى أنه معهما يسمع ويرى، وأنه حافظهما وناصرهما ومؤيدهما، فلهذا أقدما على دعوة هذا الجبار العنيد المتكبر المتغطرس الذي قال: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى[38] فصانهما وحماهما من شره وكيده.
ولا شك أن هذا كله من حفظ الله وعنايته برسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام: رجل متكبر طاغية ملك لعين يدعي أنه رب العالمين، ومع هذا أقدما على دعوته وبيان حق الله عليه، وأنه الواجب عليه أن ينيب إلى الله، ولكنه أبى واستكبر، ثم دعا إلى ما دعا إليه من جمع السحرة والسحر إلى غير ذلك، حتى أبطل الله كيده وأظهر عجزه ونصر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام عليه وعلى سحرته، ثم صارت العاقبة لما استمر في الطغيان أن أغرقه الله وجميع جنده في البحر، وخلص موسى وهارون ومن معهما من بني إسرائيل.
هذه من آيات الله البالغة، في انتقام الله من أعدائه ونصره لأوليائه: رجلان ليس معهما إلا جماعة مستعبدون لفرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويسومهم سوء العذاب، يقدمان على دعوة ملك جبار، وبيان الحق له، وإنكار ما هو عليه من الباطل، فيحميهما الله من ظلمه وبطشه، بل ويثبتهما ويؤيدهما جل وعلا، وينطقه بما يقيم الحجة عليه، ولهذا قال في الآية الأخرى: فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى * قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى * قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى * كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى * مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى[39].
والمقصود أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بينوا الحق وأوضحوه وبينوا أسماء الرب وصفاته الدالة على قدرته العظيمة واستحقاقه العبادة وأنه الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لكل شيء جل وعلا، وبينوا أيضا علو الله وفوقيته على خلقه.
ولهذا قال فرعون لوزيره هامان: ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى[40]، أخبره أن الله فوق السماء جل وعلا. ولهذا أراد هذا الجبار أن يتطاول بهذا الكلام القبيح الساقط الذي لا قيمة له.
ومن هذا ما ذكره الله جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريين في سورة المائدة حيث قال سبحانه: إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ * قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ * قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ[41] ففي هذا بيان شيء من قدرة الله جل وعلا، وأنه سبحانه القادر على كل شيء، وأنه سبحانه في العلو، لأن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل، فإنزال المائدة وطلب إنزالها، كل ذلك دليل على أن القوم قد عرفوا أن ربهم في العلو، فهم أعرف بالله وأعلم به من الجهمية وأضرابهم ممن أنكر العلو. فالحواريون طلبوا ذلك وعيسى بين لهم ذلك والله بيّن ذلك أيضا، ولهذا قال: إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ[42] فدل ذلك على أن ربنا جل وعلا يطلب من أعلى، وأنه في العلو سبحانه وتعالى فوق السموات وفوق جميع الخلائق وفوق العرش، قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا.
وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات مصرحة بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ومن ذلك آيات الاستواء السبع المعروفة التي فيها قوله سبحانه في سورة الأعراف: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ[43]، وفي هذه الآية يبين علوه، وأنه الخلاق الرزاق، وأنه صاحب الخلق والأمر سبحانه وتعالى، وأنه الذي يغشي الليل النهار، وأنه خالق الشمس والقمر، وخالق النجوم، ليعلم العباد عظيم شأنه، وكمال قدرته وكمال علمه سبحانه، وأنه العالي فوق جميع خلقه، المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى.
ومن هذا الباب قول الله عز وجل: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ[44]، فانظر كيف بين هذه الصفات العظيمة لله عز وجل الداعية إلى عبادته وحده، دون كل ما سواه، وأنه علام الغيوب وأنه العزيز الحكيم، وأنه الرقيب على عباده، والشهيد عليهم، وأنه يعلم ما في نفس نبيه عيسى، وعيسى لا يعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى.
وفي هذا أيضا دلالة على إثبات الصفات، وأن الأنبياء جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يوصف بأن له نفسا تليق به عز وجل لا تشابه نفوس المخلوقين، كما أنه سبحانه له وجه وله يد وله قدم وله أصابع لا تشابه صفات المخلوقين، جاء بعض هذا في الكتاب العزيز، وجاء في السنة المطهرة ذكر الوجه واليد والقدم والأصابع كل ذلك دليل على أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال، وأنه لا يلزم من ذلك مشابهته للخلق، ولهذا قال عز وجل: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ[45] سبحانه وتعالى. فنفى عن نفسه المماثلة ثم أثبت لنفسه السمع والبصر، فدل ذلك على أن صفاته وأسماءه لا شبيه له فيها، ولا مثيل له فيها. بل هو جل وعلا الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المستحق لأن يعبد ويعظم جل وعلا.
أما المخلوقون فصفاتهم ضعيفة وناقصة، أما هو جل وعلا فهو الكامل في كل شيء، فعلمه كامل وصفاته كاملة كلها ولا شك أن صفات المخلوقين لا تماثل صفاته أبدا بوجه من الوجوه ولهذا قال سبحانه: فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[46]، وقال عز وجل: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ[47] وقال سبحانه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ[48].
فأهل السنة والجماعة يثبتون ما ورد في كتاب الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان، بل يثبتونها كما جاءت ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق، وأنها ثابتة لله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يشابه فيه خلقه، كما قال عز وجل: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ[49]. وهذه المسائل من مسائل التوحيد، وهي من أهم المسائل، والله سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز أسماءه وصفاته، وكرر ذلك في مواضع كثيرة حتى يعرف الله سبحانه وتعالى بعظيم أسمائه، وعظيم صفاته وعظيم أفعاله جل وعلا، فأفعاله كلها جميلة وأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها عُلى، وبذلك يعلم العباد ربهم وخالقهم فيعبدونه على بصيرة وينيبون إليه على علم، وأنه يسمع دعاءهم، ويجيب مضطرهم، وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.
ومن هذا ما ذكره الله جل وعلا عن قوم موسى من بني إسرائيل لما عبدوا العجل أوضح لهم سبحانه فساد أمرهم، وبطلان ما فعلوه، فقال جل وعلا: وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ[50]، فبين لنا أن الإله المستحق للعبادة يجب أن يكون متكلما، وأن يكون سميعا بصيرا، وأن يكون يهدي السبيل، وأن يكون بين القدرة على كل شيء، والعلم لكل شيء، أما عجل جماد يعبد من دون الله، فهذا من فساد العقول: عجل لا يجيب الداعي، ولا يبين كلاما، ولا يرد جوابا ولا ينفع ولا يضر، فكيف يعبد من دون الله.
وفي الآية الأخيرة يقول جل وعلا: أَفَلا يَرَوْنَ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا[51] أي أنه لا يرجع لهم قولا، ومعنى يرجع يرد، فإن رجعك الله: ردك الله، يعني أن هذا العجل لا يرد قولاً لمن كلمه وخاطبه، ولا يملك ضرا ولا نفعا، فكيف تصرف له العبادة لو كانت العقول سليمة، وهذا المعنى في كتاب الله كثير جدا، يبين الله سبحانه وتعالى لعباده أنه المستحق للعبادة لكماله وقدرته العظيمة، وأنه المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، الذي يسمع دعاء الداعين، ويقدر على قضاء حاجتهم ويجيب مضطرهم، ويملك الضر والنفع، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، سبحانه وتعالى.
وقد بعث الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، وأفضلهم وإمام المرسلين، بعثه بما بعث به المرسلين الأولين، من توحيد الله والإخلاص له والدعوة إلى ذلك، وبيان صفاته وأسمائه وأنه المستحق لأن يعبد جل وعلا، فكانت دعوته دعوة كاملة، قال جل وعلا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا[52]، وأنزل عليه كتاباً عظيماً وهو أشرف الكتب وأعظمها وأنفعها وأعمها، بين فيه أدلة التوحيد، وأنه الرب العظيم، القادر على كل شيء المالك، لكل شيء، النافع الضار، وأمر نبيه أن يبلغ الناس ذلك في آيات كثيرات، من تدبر القرآن عرفها كما قال سبحانه: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ[53]، وقال سبحانه: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ[54] فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحتج عليهم بما أقروا به من أفعال الرب وقدرته، وأنه يحيي ويميت، وأنه المدبر الرزاق، على ما جحدوا في توحيد العبادة وأنكروه.
والمعنى: إذا كنتم مقرين بأن هذا هو ربكم الذي يملك الضر والنفع، ويدبر الأمور ويحيي ويميت ويرزق عباده، فكيف لا تتركون الإشراك به، وتعبدونه وحده دون ما سواه جل وعلا، ومن هذا قوله سبحانه: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ[55] والآيات بعدها.
فكل هذا تذكير من الله لعباده على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعظيم حقه وبأسمائه وصفاته، وأنه عز وجل المستحق لأن يعبد لكمال قدرته، وكمال علمه، وكمال إحسانه، وأنه النافع الضار وهو القادر على كل شيء، المتفرد في أفعاله وأسمائه وصفاته عن المشابه والنظير جل وعلا.
ولما بعث الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام، بدأ دعوته بالتوحيد، كالرسل السابقين سواء، فقال لقريش: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هكذا بدأهم، ما أمرهم بالصلاة أو الزكاة أولا أو ترك الخمر أو الزنا أو شبه ذلك. لا، بل بدأهم بالتوحيد لأنه الأساس، فإذا صلح الأساس جاء غيره بعد ذلك. فبدأهم بالأساس العظيم وهو توحيد الله والإخلاص له، والإيمان به وبرسله.
فأساس الملة وأساس الدين في شريعة كل رسول توحيد الله والإخلاص له، فتوحيد الله والإخلاص هو دين جميع المرسلين، وهو محل دعوتهم جميعاً، وزبدة رسالتهم عليهم الصلاة والسلام كما سلف، ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقومه: ((قولوا لا إله إلا الله)) استنكروا ذلك، واستغربوه، لأنه خلاف ما هم عليه وآباؤهم، فقد ساروا على الشرك، وعبادة الأوثان من دهر طويل، بعدما غير عليهم دينهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان رئيسا في مكة، فيقال أنه سافر إلى الشام، ووجد الناس يعبدون الأصنام هناك، فجاء إلى مكة ودعا الناس إلى عبادة الأصنام تقليدا للكفار هناك، ويقال إنه قيل له: إيت جدة، تجد فيها، أصناما معدة، فخذها ولا تهب، وادع العرب إلى عبادتها تجب.
فاستخرجها ونشرها بين العرب فعبدوها وهي: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، التي كانت معبودة في قوم نوح. فاشتهرت بين العرب، وعبدت من دون الله، بسبب عمرو بن لحي المذكور، ثم أوجدوا أصناماً وأوثاناً أخرى في سائر القبائل يعبدونها مع الله، يسألونها قضاء الحوائج، ويجعلونها آلهة مع الله، ويتقربون إليها بأنواع القربات كالذبح والنذر والدعوات والتمسح وغير ذلك.
ومن ذلك العزى لأهل مكة، ومناة لأهل المدينة ومن حولهم، واللات لأهل الطائف ومن حولهم، إلى غير ذلك من الأوثان والأصنام الكثيرة في العرب، فلما دعاهم هذا النبي الكريم رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله وترك آلهتهم، أنكروا عليه ذلك وقالوا: أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ[56]، وقال جل وعلا عنهم في سورة الصافات: إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ[57] فانظر يا أخي كيف غلب عليهم الجهل حتى جعلوا الدعوة إلى توحيد الله أمراً عجاباً، واستكبروا عنه واستغربوه وعادوا من دعاهم إليه حتى قاتلوه، وانتهى الأمر أن أجمعوا رأيهم على قتله، فأنجاه الله من مكرهم، وهاجر من بين أظهرهم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم حاولوا قتله أيضا يوم بدر فلم يفلحوا، وحاولوا ذلك يوم أحد بأشد مما قبل، فكفاه الله مكرهم وكيدهم، ثم حاولوا يوم الأحزاب استئصال الدعوة والقضاء على الرسول وأصحابه، فأبطل الله كيدهم وفرق شملهم، وأنجاه الله من شرهم ومكائدهم، ونصر دينه وأيد دعوته، وأعانه على جهاد أعدائه حتى أقر الله عينه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بانتصار دين الله وظهور الحق، وانتشار التوحيد في الأرض، والقضاء على الأوثان والأصنام، بعدما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجاً بسبب فتح الله عليه مكة، ودخول قريش في الإسلام، ثم تتابعت العرب في الدخول في دين الله وقبول ما دعا إليه عليه أفضل الصلاة والسلام، من توحيد الله والإخلاص له جل وعلا، والتمسك بشريعته سبحانه وتعالى.
والمقصود أن رسولنا ونبينا محمداً عليه الصلاة والسلام دعا إلى ما دعت إليه الرسل قبله من نوح ومن بعده، إلى توحيد الله والإخلاص له، وترك عبادة ما سواه. هذه أول دعوته، وهذه زبدتها، وهي أهم واجب وأول واجب، وأعظم واجب، وكان بنو آدم على التوحيد من عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام عشرة قرون، كما قال ابن عباس وجماعته، فلما اختلفوا بسبب الشرك الذي وقع في قوم نوح، بعث الله الرسل قال الله عز وجل: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ[58] المعنى كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان، فاختلفوا بعد ذلك، كما قال في آية أخرى في سورة يونس: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا[59].
فالمعنى أنهم كانوا على التوحيد والإيمان، هذا هو القول الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك بينهم بسبب دعوة الشيطان إلى عبادة ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر.
فلما وقع الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين، وتزيين الشيطان لهم عبادتهم من دون الله، بعث الله إليهم نوحاً عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى توحيد الله والإخلاص له، وترك عبادة ما سواه جل وعلا.
فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيها، أما آدم فجاءت أحاديث ضعيفة تدل على أنه نبي ورسول مكلم، لكنها لا يعتمد عليها لضعف أسانيدها، ولا شك أنه أوحي إليه بشرع وأنه على شريعة من ربه عليه الصلاة والسلام، وكانت ذريته على شريعته وعلى توحيد الله، والإخلاص له، ثم بعد ذلك بعشرة قرون أو ما شاء الله من ذلك، وقع الشرك في قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كما تقدم.
وقد جاء في الآثار المشهورة عن ابن عباس وغيره، أن ودًّا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا رجالا صالحين، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت من دون الله عز وجل.
أي لما ذهب العلم وقل العلماء المتبصرون جاء الشيطان إلى الناس فقال لهم: إن هذه الأصنام إنما صورت لأنها كانت تنفع وكانت تدعى ويستغاث بها، ويستسقى بها، فوقع الشرك في الناس بسبب ذلك.
وبهذا يعلم أن نوحاً عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، بعد وقوع الشرك فيها، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من أن أهل الموقف يوم القيامة يقولون: ((يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك)) الحديث.
أما آدم فقد ثبتت نبوته قبل ذلك عليه الصلاة والسلام بدلائل أخرى. وجاء في حديث أبي ذر عن أبي حاتم بن حبان وغيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسل وعن الأنبياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر)) وفي رواية أبي أمامة ثلاثمائة وخمسة عشر ولكنهما حديثان ضعيفان عند أهل العلم، ولهما شواهد ولكنها ضعيفة أيضا، كما ذكرنا آنفا، وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام: ((ألف نبي فأكثر)) وفي بعضها: ((أن الأنبياء ثلاثة آلاف)) وجميع الأحاديث في هذا الباب ضعيفة، بل عد ابن الجوزي حديث أبي ذر من الموضوعات، والمقصود أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه، فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكنهم جم غفير، قص الله علينا أخبار بعضهم ولم يقص علينا أخبار البعض الآخر، لحكمته البالغة جل وعلا، والفائدة العظمى أن نعرف أنهم جميعهم دعوا إلى توحيد الله، والإخلاص له سبحانه وتعالى، وأنهم دعوا أممهم إلى ذلك، فمنهم من قبل هذه الدعوة، ومنهم من ردها، ومنهم من لم يتبعه إلا القليل ومنهم من لم يجبه أحد بالكلية كما أخبر بذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
ونبينا وهو خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام قد علم ما جرى له مع قومه من الخصومة والنزاع في مكة المكرمة، وقد أوذي كثيرا هو وأصحابه حتى أجمعوا على قتله، فأنجاه الله من بين أظهرهم، وفي المدينة جرى ما جرى من الغزوات والجهاد العظيم حتى نصره الله وأيده عليهم عليه الصلاة والسلام، وبذلك يتضح للجميع أن دعوة الرسل جميعهم، هي دعوة إلى توحيد الله والإخلاص له، وأن الأنبياء جميعا، والمرسلين كلهم دعوا إلى توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في استحقاقه العبادة دون كل ما سواه جل وعلا، فلا يستحقها غيره لا نبي ولا ملك ولا صالح ولا غيرهم من المخلوقات، فالعبادة حق الله جل وعلا، ولها خلق الخلق سبحانه وتعالى، وبها أرسل الرسل كما قال سبحانه وتعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ[60]، وقال تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ[61] فلعبادة الله وتوحيده خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ[62]، وقال سبحانه: هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ[63].
وقد أبان الله سبحانه في كتابه العزيز من آياته ومخلوقاته ما يدل على قدرته العظيمة، وألوهيته وربوبيته، وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ومن تدبر كتاب الله ومخلوقاته وجد من الآيات المتلوة والحسية والأخبار المنقولة، ما يدل على أنه سبحانه المستحق للعبادة جل وعلا، وأن الرسل كلهم بلغوا ذلك ودعوا إليه، وأن الشرك الذي وقع في قوم نوح لم يزل في الناس إلى يومنا هذا، فلم يزل في الناس من يعبد الأصنام والأوثان، ويغلو في الصالحين والأنبياء، يعبدهم مع الله، كما هو معلوم عند كل من نظر في أخبار العالم من عهد نوح إلى يومنا هذا.
وبما ذكرنا من كتاب الله عز وجل، ومن كلام رسوله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومن واقع العالم يتضح أن التوحيد أقسام وقد عرف ذلك أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
فهو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أفعاله، وخلقه وتدبيره لعباده، وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالى، بعلمه وقدرته جل وعلا.
والثاني: توحيد الأسماء والصفات، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، وأنه لا شبيه له ولا نظير له، ولا ند له عز وجل.
الثالث: توحيد العبادة وأنه يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، دون ما سواه جل وعلا. وإن شئت قلت توحيد الله سبحانه وتعالى: هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع، ورازق الجميع، وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك ل

منتديات عرب مسلم | منتدى برامج نت | منتدى عرب مسلم | منتديات برامج نت | منتدى المشاغب | منتدى فتكات | منتديات مثقف دوت كوم | منتديات العرب | إعلانات مبوبة مجانية | إعلانات مجانية | اعلانات مبوبة مجانية | اعلانات مجانية | القرآن الكريم | القرآن الكريم قراءة واستماع | المكتبة الصوتية للقران الكريم mp3 | مكتبة القران الكريم mp3 | ترجمة القرآن | القرآن مع الترجمة | أفضل ترجمة للقرآن الكريم | ترجمة القرآن الكريم | Quran Translation | Quran with Translation | Best Quran Translation | Quran Translation Transliteration | تبادل إعلاني مجاني