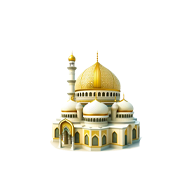( لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) وسام شرفٍ علّقه النبي– صلى الله عليه وسلم – على صدور أصحابه الذين شاركوه في أكبر انتصاراته وأعظمها ، وكيف لا ؟ ويوم بدر كان فاصلاً بين مرحلتين : مرحلة الاستضعاف والإذلال ، ومرحلة المواجهة والتمكين ، وفاصلاً بين فريقين ، فريقٌ يُقاتل في سبيل الله ، وآخر يُقاتل في سبيل الطاغوت ، فكان من حق هذا اليوم أن يُسمّى (بيوم الفرقان ) كما في كتاب الله تعالى.
وتعتبر هذه الغزوة المباركة يوماً عظيماًً من أيام التاريخ الإسلامي ، حيث كانت البداية الحقيقيّة لظهور المسلمين وعلوّهم ، وكل انتصارٍ تلى ذلك اليوم سيظل مديناً لهذه المعركة التي كانت شرارة البدء للفتوح الإسلامية ، فكيف بدأت هذه الغزوة ؟ وما هي بواعثها ؟ .
نقطة البداية كانت في السنة الثانية من الهجرة ، حينما سمع المسلمون بقدوم قافلةٍ عظيمة من الشام تحمل أموال قريشٍ وتجارتها ، ويقودها أبو سفيان مع عددٍ محدود من رجاله ، فرأى فيها النبي – صلى الله عليه وسلم – فرصةً سانحةً لتوجيه ضربةٍ موجعةٍ إلى عصب الحياة الاقتصاديّة لأهل مكّة ، فضلاً عن كونها تعويضاً عن الأموال التي استولى عليها المشركون من المهاجرين ، فحثّ النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه على الخروج قائلاً : ( هذه عير قريش ، فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها لعل الله أن يُنفلكموها – أي يجعلها غنيمة - ) رواه ابن إسحاق .
لقد كانت النيّة إذاً ملاحقة القافلة واغتنامها ، ولذلك لم يخرج من الصحابة سوى ثلاثمائة وبضعة عشر رجل ، معهم فَرَسان وسبعون بعيراً يتعاقبون عليها في الركوب .
وكان من نصيب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعيرٌ يتعاقب عليه هو وأبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، الذين عرضا عليه أن يتركا له البعير ليركبه ، فقال لهما : ( ما أنتما بأقوى مني ، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما ) رواه أحمد .
ووصلت الأنباء إلى أبي سفيان بخروج النبي – صلى الله عليه وسلم – فأصابه الرعب ، وأرسل رجلاً يُقال له ضمضم بن عمرو الغفاري ليستنجد بأهل مكّة كي ينقذوا أموالهم من أيدي المسلمين .
ويقدّر الله في ذلك الوقت أن ترى عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا غريبة ، كانت تتعلّق بقدوم راكبٍ إلى مكّة ووقوفه بين الناس ، ثم صراخه بأعلى صوته : ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم ، وصعوده إلى رأس جبل أبي قبيس وأخذه لصخرة كبيرة قام بقذفها من رأس الجبل ، فتحوّلت تلك الصخرة إلى فتات تناثر على جميع بيوت مكّة ، وتناقل الناس تلك الرؤيا بين مصدّقٍ لها وساخرٍ منها .
وجاءت الأيام لتصدّق تلك الرؤيا ، فبعد ثلاثة أيامٍ تحديداً وصل ذلك الرجل ، وقام يصرخ في الناس قائلاً : " يا معشر قريش ، اللطيمة اللطيمة ، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه ، لا أرى أن تدركوها ، الغوث الغوث "
فنهضت قريشٌ برجالها وعتادها ، ولم يتخلّف من أشرافهم سوى أبي لهب ، والذي بعث رجلاً نيابةً عنه ، وسرعان ما احتشدت القوّات من بطون قريشٍ وما حولها من القبائل ، حتى بلغ عددهم ألفاً وثلاثمائة مقاتل ، وهم يحدّثون أنفسهم بسهولة المهمّة ، ولم يعلموا أن الأمور ستتطوّر إلى معركة فاصلة ويوم مشهودٍ في تاريخ البشريّة .
وفي هذه الأثناء كان أبو سفيان في قمة توتره وتحفزّه ، فلو تمكّن المسلمون من الوصول والاستيلاء على القافلة فستكون خسارة فادحة لقريش ، لذلك لم يدّخر جُهداً في تتبّع أخبار المسلمين ورصد تحرّكاتهم ، حتى سمع عن راكِبَيْنِ نزلا بالقرب منه ، فذهب إلى موضعهما ، وقام بفحص البعر الذي خلّفته الإبل ، فرأى فيها أثراً لنوى تمر المدينة ، فعلم أن المسلمين قريبين منه ، فأسرع في تغيير خط سير القافلة واتخذ طريق الساحل ، وتمكّن من الهرب.
ولمّا رأى أنه تجاوز مرحلة الخطر أرسل إلى قريش قائلا : "إن الله قد نجّى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا " ، فاستحسنت بنو عديّ رأيه وعادت إلى مكّة ، لكنّ أبا جهل أصرّ على المضيّ في قتال المسلمين بالذين معه ، وقال : " والله لا نرجع حتى نأتي بدراً فنقيم بها ثلاثاً ، فنطعم بها الطعام ، وننحر بها الجزر ، ونسقى بها الخمر ، وتعزف علينا القيان – أي المغنّيات - ، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا ، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً " ، وكانت جهالة أبي جهل وغروره هي بداية النهاية لأشراف قريش .
ووصلت الأنباء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بعزم قريش على القتال ، فأراد أن يُوقف الصحابة على حقيقة الموقف وحتميّة المواجهة ، لكن مواقف الصحابة تباينت ، فقد أظهر فريقٌ منهم كراهيّته للمواجهة ، لعدم استعدادهم لها ، وقام يراجع النبي – صلى الله عليه وسلم – في ذلك ، وقد سجّل القرآن موقفهم في قوله تعالى : { كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكرهون ، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون } ( الأنفال : 5-6 ).
بينما أيّد قادة المهاجرين فكرة القتال وتحمّسوا لها ، وقال المقداد رضي الله عنه للنبي – صلى الله عليه وسلم - : " والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : { اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون } (المائدة :24 ) ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ، ومن بين يديك ومن خلفك " رواه البخاري ، فأشرق وجه النبي – صلى الله عليه وسلم - لقوله .
لكن النبي – صلى الله عليه وسلم – أراد أن يطّلع على موقف الأنصار ، فهم أغلب الجند ، وبيعة العقبة لم تكن تُلزِمُهم بحماية النبي – صلى الله عليه وسلم – خارج نطاق المدينة ، فظلّ يردّد قائلاً : ( أشيروا عليَّ أيها الناس ) ، فأدرك سعد بن عبادة مُراد النبي عليه الصلاة والسلام فقال : " إيانا تريد يا رسول الله ؟ ، قد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، لا يتخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا ، إنا لصُبر عند الحرب صدق عند اللقاء ، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسِر بنا على بركة الله " ، فأشعلت تلك الكلمات الصادقة حماسة الصحابة فاستقرّ رأيهم على القتال ، ووثقوا بموعود الله ونصره ، وسُرّ النبي – صلى الله عليه وسلم – من جوابهم وقال : ( سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم ) رواه ابن إسحاق .
وبدأ النبي – صلى الله عليه وسلم – يُعدّ الناس للمواجهة المرتقبة ، وبدأ بتنظيم أصحابه وتقسيمهم على ثلاثة ألوية ، وجعل لواء الحرب عند مصعب بن عمير رضي الله عنه ، وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ثم استعرض أصحابه فأخرج الصغار ومنعهم من المشاركة في القتال ، وكان من بين أولئك عبدالله بن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهما .
وبينما هو كذلك إذ أقبل رجل من المشركين يريد أن يُشارك في القتال ، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم - : ( ارجع فلن استعين بمشرك ) ، وعاود المحاولة مراراً ورسول الله يكرّر الجواب ذاته ، حتى أعلن الرجل إسلامه فسمح له النبي – صلى الله عليه وسلم – بالخروج معه ، رواه أحمد .
وواصل الجيش مسيره حتى بلغوا قريباً من بئرٍ يقال لها بدر ، فأرسل النبي – صلى الله عليه وسلم نفراً من أصحابه لاستطلاع أخبار المشركين ، فوجدوا غلامين من غلمان قريش فقبضوا عليهما ، واقتادوهما إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - ، فحاول عليه الصلاة والسلام أن يستعلم منهما إمكانات قريشٍ وعدد أفرادها لكنهما رفضا الإجابة ، فقال لهم : ( كم ينحرون من الجزر –أي الإبل - ؟ ) فقالا : عشرا كل يوم ، فعلم النبي - صلى الله عليه وسلم – أن عددهم يقارب ألف مقاتل ، فأقبل على الناس فقال : ( هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها ) رواه ابن إسحاق .
إذاً فالوضع خطير ، والعدوّ يفوقهم عدداً وعُدّة ، فما أحوجهم في تلك اللحظات إلى عونٍ إلهيّ ومثبّتات إيمانية ، تُلقي على قلوبهم السكينة واليقين بحصول النصر ، فأرسل الله تعالى على المؤمنين أمطار خيرٍ وبركة ، كان لها أثرٌ بالغٌ على النفوس فطهّرتها ، وعلى القلوب فاستيقنت بالنصر وتسلّحت بالصبر ، وعلى الأرض فتماسكت تربتها واشتدّت.
كما أيّد الله تعالى المؤمنين بالنعاس الذي أصابهم تلك الليلة ، فكان سبباً في إزالة الخوف ويثّ السكينة في القلوب ، وقد سجّل القرآن تلك اللحظات ، قال تعالى : { إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام } ( الأنفال : 11 ).
ومما رجّح الكفة لصالح المسلمين الخلاف الذي نشأ بين زعامات قريش ، فقد حاول عُتبة بن ربيعة أن يُثني الناس عن الدخول في المعركة ، وأنكر عليهم قتال أنسابهم وأرحامهم ، وحذّرهم من شجاعة المسلمين وبسالتهم في القتال ، فاتهمه أبو جهل بالجبن والضعف ، وأصرّ على مواصلة الزحف ، وكان تعليق النبي – صلى الله عليه وسلم – على ذلك الموقف أن قال : ( إن يك عند أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر – يعني عُتبة بن ربيعة - إن يطيعوه يرشدوا ) رواه ابن أبي شيبة .
وبدأ السباق الشديد نحو ماء بدر بين كلا الفريقين ، حتى تمكّن جيش المسلمين من سبق أعدائهم والنزول بالقرب منها ، وفي تلك الأثناء وقف الحباب بن منذر رضي الله عنه يطوف ببصره في أرجاء المعسكر يتأمّله بعينٍ فاحصة ، ويستحضر معارفه السابقة في تضاريس المنطقة ، فلم يُعجبه اختيار المكان ، وبدا له رأيٌ آخر ، فذهب إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – مسرعاً وسأله إن كان اختيار ذلك الموضع وحياً من الله لا مجال للرأي فيه أم أنه مجرّد اجتهاد ، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم : ( بل هو الرأي والحرب والمكيدة ) ، فاقترح عليه أن ينزلوا عند أقرب الآبار إلى المشركين ثم يقوموا بردم بقيّة الآبار ليحرموا جيش المشركين من الماء ، فأُعجب النبي – صلى الله عليه وسلم – بالفكرة ووضعها قيد التنفيذ .
وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه باقتراح آخر ، وذلك بأن يقوموا ببناء عريش – وهي الخيمة من الخشب – لكي تكون مكاناً للقيادة والاطلاع على مجريات الأحداث ، إضافةً إلى كونها مقرّاً آمنا للنبي – صلى الله عليه وسلم – للحفاظ على حياته ، فتمّت الموافقة وبُني العريش .
واصطفّ الجيشان ، وقام النبي - صلى الله عليه وسلم – يتفقّد جنده ، يقدم هذا ويؤخّر ذاك ، ويشجّع الناس ويُسدي النصائح ؛ فإن اللقاء المرتقب سيكون صعباً ، وبعد التأكد من دور التعبئة النفسية ، عاد إلى عريشه ليتمّم أسباب النصر بالدعاء فيستنصر ربه ويتذلّل لمولاه : ( اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني ، اللهم إن تُهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض ، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني ) واشتدّت مناشدته لربّه حتى سقط عنه رداؤه ، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه وأعاده إلى مكانه ، ثم احتضنه من ورائه وقال : " يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك ؛ فإنه سينجز لك ما وعدك " .
عندها خرج النبي – صلى الله عليه وسلم – من عريشه وقال لعلي : ( ناولني كفاً من حصى ) ، فناوله إياها ، فأخذها النبي – صلى الله عليه وسلم - فرمى بها وجوه المشركين ، وبقدرة الله تعالى ، وصلت تلك الحصيات إليهم ، فما بقى أحدٌ منهم إلا امتلأت عيناه منها ، كما قال تعالى : { وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى } ( الأنفال : 17 ).
وبدأت المعركة بمبارزة قويّة بين عتبة بن ربيعة وحمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه ، وبين الوليد بن عُتبة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه ، وبين شيبة بن ربيعة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فانتصر حمزة وعلي ، في حين سقط عتبة وشيبة مثخنين بالجراح ، فأجهز حمزة وعلي على الوليد ثم عادا بعبيدة إلى معسكر المسلمين .
والتحم الفريقان ، وتصاعدت حميّة المسلمين وتعالت التكبيرات ، يتقدّمهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصول ويجول في أرض المعركة كأنّه جيشٌ وحده ، حتى قال الصحابة يومئذٍ : " قد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أقربنا إلى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا " ، وانطلقت هتافاته - صلى الله عليه وسلم - قائلةً : ( قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ) فوصلت تلك الكلمات إلى قلب عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه ، فرمى بتمرات كانت بيده وقال : " لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة " ، ثم انطلق كالسهم يشقّ صفوف المشركين وهو يضرب بسيفه يمنةً ويسره حتى سقط شهيداً .
وجاء المدد الإلهي بقوّات مساندة من آلاف الملائكة لتثبّت الذين آمنوا وترجّح الكفّة لصالحهم ، يقودهم جبريل عليه السلام بفرسه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، منها قول ابن عباس رضي الله عنه : " بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه ، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم – اسم الدابة التي يركبها الملك - ، فنظر إلى المشرك أمامه ، فخرّ مستلقيا ، فإذا هو قد خطم أنفه – قطع أنفه - وشق وجهه كضربة السوط " ، وقول أبي داود المازني : " إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل سيفي إليه ، فعرفت أنه قتله غيري " .
وتزعزعت صفوف المشركين ودب الرعب في قلوبهم ، فلم يكونوا يتصوّرون أن هذه الفئة المؤمنة قليلة العدد ومحدودة الإمكانات تستطيع أن تقف في وجوههم وتنتصر عليهم ، وسرعان ما تساقطت جثث المشركين وجن جنون أبي جهل - فرعون هذه الأمة - وهو يرى الهزيمة تنزل بأصحابه ، ولم يعلم أن موعده مع المنيّة أقرب مما يظنّ ، ليس على يد قيادات المسلمين أو فرسانهم ، ولكن على أيدٍ غضّة من فتية مؤمنة ، يقول عبد الرحمن بن عوف : " إني لفي الصف يوم بدر ، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن ، فكأني لم آمن بمكانهما ، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه : يا عم ، أرني أبا جهل ، فقلت : يا ابن أخي ، وما تصنع به ؟ ، قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه ، فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله ، فأشرت لهما إليه ، فشدا عليه – أي انطلقا نحوه - مثل الصقرين حتى ضرباه " وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما.
وانجلت المعركة عن خسارة فادحة لقريش ، فقد قٌُتل سبعون رجلاً من أشرافهم ، وأُسر منهم سبعون ، فولّوا الأدبار يجرّون أذيال الخيبة ، بينما لم يُقتل من المسلمين سوى أربعة عشر شهيداً ، قدّموا أرواحهم قرباناً لهذا النصر العظيم ، الذي ذاق المسلمون حلاوته ، وخلّد الله ذكره في سورة كاملة ، ليبقى شاهد حقٍ على نُصرة الله لأوليائه ودفاعهم عنه .

وتعتبر هذه الغزوة المباركة يوماً عظيماًً من أيام التاريخ الإسلامي ، حيث كانت البداية الحقيقيّة لظهور المسلمين وعلوّهم ، وكل انتصارٍ تلى ذلك اليوم سيظل مديناً لهذه المعركة التي كانت شرارة البدء للفتوح الإسلامية ، فكيف بدأت هذه الغزوة ؟ وما هي بواعثها ؟ .
نقطة البداية كانت في السنة الثانية من الهجرة ، حينما سمع المسلمون بقدوم قافلةٍ عظيمة من الشام تحمل أموال قريشٍ وتجارتها ، ويقودها أبو سفيان مع عددٍ محدود من رجاله ، فرأى فيها النبي – صلى الله عليه وسلم – فرصةً سانحةً لتوجيه ضربةٍ موجعةٍ إلى عصب الحياة الاقتصاديّة لأهل مكّة ، فضلاً عن كونها تعويضاً عن الأموال التي استولى عليها المشركون من المهاجرين ، فحثّ النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه على الخروج قائلاً : ( هذه عير قريش ، فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها لعل الله أن يُنفلكموها – أي يجعلها غنيمة - ) رواه ابن إسحاق .
لقد كانت النيّة إذاً ملاحقة القافلة واغتنامها ، ولذلك لم يخرج من الصحابة سوى ثلاثمائة وبضعة عشر رجل ، معهم فَرَسان وسبعون بعيراً يتعاقبون عليها في الركوب .
وكان من نصيب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعيرٌ يتعاقب عليه هو وأبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، الذين عرضا عليه أن يتركا له البعير ليركبه ، فقال لهما : ( ما أنتما بأقوى مني ، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما ) رواه أحمد .
ووصلت الأنباء إلى أبي سفيان بخروج النبي – صلى الله عليه وسلم – فأصابه الرعب ، وأرسل رجلاً يُقال له ضمضم بن عمرو الغفاري ليستنجد بأهل مكّة كي ينقذوا أموالهم من أيدي المسلمين .
ويقدّر الله في ذلك الوقت أن ترى عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا غريبة ، كانت تتعلّق بقدوم راكبٍ إلى مكّة ووقوفه بين الناس ، ثم صراخه بأعلى صوته : ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم ، وصعوده إلى رأس جبل أبي قبيس وأخذه لصخرة كبيرة قام بقذفها من رأس الجبل ، فتحوّلت تلك الصخرة إلى فتات تناثر على جميع بيوت مكّة ، وتناقل الناس تلك الرؤيا بين مصدّقٍ لها وساخرٍ منها .
وجاءت الأيام لتصدّق تلك الرؤيا ، فبعد ثلاثة أيامٍ تحديداً وصل ذلك الرجل ، وقام يصرخ في الناس قائلاً : " يا معشر قريش ، اللطيمة اللطيمة ، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه ، لا أرى أن تدركوها ، الغوث الغوث "
فنهضت قريشٌ برجالها وعتادها ، ولم يتخلّف من أشرافهم سوى أبي لهب ، والذي بعث رجلاً نيابةً عنه ، وسرعان ما احتشدت القوّات من بطون قريشٍ وما حولها من القبائل ، حتى بلغ عددهم ألفاً وثلاثمائة مقاتل ، وهم يحدّثون أنفسهم بسهولة المهمّة ، ولم يعلموا أن الأمور ستتطوّر إلى معركة فاصلة ويوم مشهودٍ في تاريخ البشريّة .
وفي هذه الأثناء كان أبو سفيان في قمة توتره وتحفزّه ، فلو تمكّن المسلمون من الوصول والاستيلاء على القافلة فستكون خسارة فادحة لقريش ، لذلك لم يدّخر جُهداً في تتبّع أخبار المسلمين ورصد تحرّكاتهم ، حتى سمع عن راكِبَيْنِ نزلا بالقرب منه ، فذهب إلى موضعهما ، وقام بفحص البعر الذي خلّفته الإبل ، فرأى فيها أثراً لنوى تمر المدينة ، فعلم أن المسلمين قريبين منه ، فأسرع في تغيير خط سير القافلة واتخذ طريق الساحل ، وتمكّن من الهرب.
ولمّا رأى أنه تجاوز مرحلة الخطر أرسل إلى قريش قائلا : "إن الله قد نجّى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا " ، فاستحسنت بنو عديّ رأيه وعادت إلى مكّة ، لكنّ أبا جهل أصرّ على المضيّ في قتال المسلمين بالذين معه ، وقال : " والله لا نرجع حتى نأتي بدراً فنقيم بها ثلاثاً ، فنطعم بها الطعام ، وننحر بها الجزر ، ونسقى بها الخمر ، وتعزف علينا القيان – أي المغنّيات - ، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا ، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً " ، وكانت جهالة أبي جهل وغروره هي بداية النهاية لأشراف قريش .
ووصلت الأنباء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بعزم قريش على القتال ، فأراد أن يُوقف الصحابة على حقيقة الموقف وحتميّة المواجهة ، لكن مواقف الصحابة تباينت ، فقد أظهر فريقٌ منهم كراهيّته للمواجهة ، لعدم استعدادهم لها ، وقام يراجع النبي – صلى الله عليه وسلم – في ذلك ، وقد سجّل القرآن موقفهم في قوله تعالى : { كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكرهون ، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون } ( الأنفال : 5-6 ).
بينما أيّد قادة المهاجرين فكرة القتال وتحمّسوا لها ، وقال المقداد رضي الله عنه للنبي – صلى الله عليه وسلم - : " والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : { اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون } (المائدة :24 ) ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ، ومن بين يديك ومن خلفك " رواه البخاري ، فأشرق وجه النبي – صلى الله عليه وسلم - لقوله .
لكن النبي – صلى الله عليه وسلم – أراد أن يطّلع على موقف الأنصار ، فهم أغلب الجند ، وبيعة العقبة لم تكن تُلزِمُهم بحماية النبي – صلى الله عليه وسلم – خارج نطاق المدينة ، فظلّ يردّد قائلاً : ( أشيروا عليَّ أيها الناس ) ، فأدرك سعد بن عبادة مُراد النبي عليه الصلاة والسلام فقال : " إيانا تريد يا رسول الله ؟ ، قد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، لا يتخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا ، إنا لصُبر عند الحرب صدق عند اللقاء ، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسِر بنا على بركة الله " ، فأشعلت تلك الكلمات الصادقة حماسة الصحابة فاستقرّ رأيهم على القتال ، ووثقوا بموعود الله ونصره ، وسُرّ النبي – صلى الله عليه وسلم – من جوابهم وقال : ( سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم ) رواه ابن إسحاق .
وبدأ النبي – صلى الله عليه وسلم – يُعدّ الناس للمواجهة المرتقبة ، وبدأ بتنظيم أصحابه وتقسيمهم على ثلاثة ألوية ، وجعل لواء الحرب عند مصعب بن عمير رضي الله عنه ، وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ثم استعرض أصحابه فأخرج الصغار ومنعهم من المشاركة في القتال ، وكان من بين أولئك عبدالله بن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهما .
وبينما هو كذلك إذ أقبل رجل من المشركين يريد أن يُشارك في القتال ، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم - : ( ارجع فلن استعين بمشرك ) ، وعاود المحاولة مراراً ورسول الله يكرّر الجواب ذاته ، حتى أعلن الرجل إسلامه فسمح له النبي – صلى الله عليه وسلم – بالخروج معه ، رواه أحمد .
وواصل الجيش مسيره حتى بلغوا قريباً من بئرٍ يقال لها بدر ، فأرسل النبي – صلى الله عليه وسلم نفراً من أصحابه لاستطلاع أخبار المشركين ، فوجدوا غلامين من غلمان قريش فقبضوا عليهما ، واقتادوهما إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - ، فحاول عليه الصلاة والسلام أن يستعلم منهما إمكانات قريشٍ وعدد أفرادها لكنهما رفضا الإجابة ، فقال لهم : ( كم ينحرون من الجزر –أي الإبل - ؟ ) فقالا : عشرا كل يوم ، فعلم النبي - صلى الله عليه وسلم – أن عددهم يقارب ألف مقاتل ، فأقبل على الناس فقال : ( هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها ) رواه ابن إسحاق .
إذاً فالوضع خطير ، والعدوّ يفوقهم عدداً وعُدّة ، فما أحوجهم في تلك اللحظات إلى عونٍ إلهيّ ومثبّتات إيمانية ، تُلقي على قلوبهم السكينة واليقين بحصول النصر ، فأرسل الله تعالى على المؤمنين أمطار خيرٍ وبركة ، كان لها أثرٌ بالغٌ على النفوس فطهّرتها ، وعلى القلوب فاستيقنت بالنصر وتسلّحت بالصبر ، وعلى الأرض فتماسكت تربتها واشتدّت.
كما أيّد الله تعالى المؤمنين بالنعاس الذي أصابهم تلك الليلة ، فكان سبباً في إزالة الخوف ويثّ السكينة في القلوب ، وقد سجّل القرآن تلك اللحظات ، قال تعالى : { إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام } ( الأنفال : 11 ).
ومما رجّح الكفة لصالح المسلمين الخلاف الذي نشأ بين زعامات قريش ، فقد حاول عُتبة بن ربيعة أن يُثني الناس عن الدخول في المعركة ، وأنكر عليهم قتال أنسابهم وأرحامهم ، وحذّرهم من شجاعة المسلمين وبسالتهم في القتال ، فاتهمه أبو جهل بالجبن والضعف ، وأصرّ على مواصلة الزحف ، وكان تعليق النبي – صلى الله عليه وسلم – على ذلك الموقف أن قال : ( إن يك عند أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر – يعني عُتبة بن ربيعة - إن يطيعوه يرشدوا ) رواه ابن أبي شيبة .
وبدأ السباق الشديد نحو ماء بدر بين كلا الفريقين ، حتى تمكّن جيش المسلمين من سبق أعدائهم والنزول بالقرب منها ، وفي تلك الأثناء وقف الحباب بن منذر رضي الله عنه يطوف ببصره في أرجاء المعسكر يتأمّله بعينٍ فاحصة ، ويستحضر معارفه السابقة في تضاريس المنطقة ، فلم يُعجبه اختيار المكان ، وبدا له رأيٌ آخر ، فذهب إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – مسرعاً وسأله إن كان اختيار ذلك الموضع وحياً من الله لا مجال للرأي فيه أم أنه مجرّد اجتهاد ، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم : ( بل هو الرأي والحرب والمكيدة ) ، فاقترح عليه أن ينزلوا عند أقرب الآبار إلى المشركين ثم يقوموا بردم بقيّة الآبار ليحرموا جيش المشركين من الماء ، فأُعجب النبي – صلى الله عليه وسلم – بالفكرة ووضعها قيد التنفيذ .
وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه باقتراح آخر ، وذلك بأن يقوموا ببناء عريش – وهي الخيمة من الخشب – لكي تكون مكاناً للقيادة والاطلاع على مجريات الأحداث ، إضافةً إلى كونها مقرّاً آمنا للنبي – صلى الله عليه وسلم – للحفاظ على حياته ، فتمّت الموافقة وبُني العريش .
واصطفّ الجيشان ، وقام النبي - صلى الله عليه وسلم – يتفقّد جنده ، يقدم هذا ويؤخّر ذاك ، ويشجّع الناس ويُسدي النصائح ؛ فإن اللقاء المرتقب سيكون صعباً ، وبعد التأكد من دور التعبئة النفسية ، عاد إلى عريشه ليتمّم أسباب النصر بالدعاء فيستنصر ربه ويتذلّل لمولاه : ( اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني ، اللهم إن تُهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض ، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني ) واشتدّت مناشدته لربّه حتى سقط عنه رداؤه ، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه وأعاده إلى مكانه ، ثم احتضنه من ورائه وقال : " يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك ؛ فإنه سينجز لك ما وعدك " .
عندها خرج النبي – صلى الله عليه وسلم – من عريشه وقال لعلي : ( ناولني كفاً من حصى ) ، فناوله إياها ، فأخذها النبي – صلى الله عليه وسلم - فرمى بها وجوه المشركين ، وبقدرة الله تعالى ، وصلت تلك الحصيات إليهم ، فما بقى أحدٌ منهم إلا امتلأت عيناه منها ، كما قال تعالى : { وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى } ( الأنفال : 17 ).
وبدأت المعركة بمبارزة قويّة بين عتبة بن ربيعة وحمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه ، وبين الوليد بن عُتبة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه ، وبين شيبة بن ربيعة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فانتصر حمزة وعلي ، في حين سقط عتبة وشيبة مثخنين بالجراح ، فأجهز حمزة وعلي على الوليد ثم عادا بعبيدة إلى معسكر المسلمين .
والتحم الفريقان ، وتصاعدت حميّة المسلمين وتعالت التكبيرات ، يتقدّمهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصول ويجول في أرض المعركة كأنّه جيشٌ وحده ، حتى قال الصحابة يومئذٍ : " قد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أقربنا إلى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا " ، وانطلقت هتافاته - صلى الله عليه وسلم - قائلةً : ( قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ) فوصلت تلك الكلمات إلى قلب عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه ، فرمى بتمرات كانت بيده وقال : " لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة " ، ثم انطلق كالسهم يشقّ صفوف المشركين وهو يضرب بسيفه يمنةً ويسره حتى سقط شهيداً .
وجاء المدد الإلهي بقوّات مساندة من آلاف الملائكة لتثبّت الذين آمنوا وترجّح الكفّة لصالحهم ، يقودهم جبريل عليه السلام بفرسه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، منها قول ابن عباس رضي الله عنه : " بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه ، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم – اسم الدابة التي يركبها الملك - ، فنظر إلى المشرك أمامه ، فخرّ مستلقيا ، فإذا هو قد خطم أنفه – قطع أنفه - وشق وجهه كضربة السوط " ، وقول أبي داود المازني : " إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل سيفي إليه ، فعرفت أنه قتله غيري " .
وتزعزعت صفوف المشركين ودب الرعب في قلوبهم ، فلم يكونوا يتصوّرون أن هذه الفئة المؤمنة قليلة العدد ومحدودة الإمكانات تستطيع أن تقف في وجوههم وتنتصر عليهم ، وسرعان ما تساقطت جثث المشركين وجن جنون أبي جهل - فرعون هذه الأمة - وهو يرى الهزيمة تنزل بأصحابه ، ولم يعلم أن موعده مع المنيّة أقرب مما يظنّ ، ليس على يد قيادات المسلمين أو فرسانهم ، ولكن على أيدٍ غضّة من فتية مؤمنة ، يقول عبد الرحمن بن عوف : " إني لفي الصف يوم بدر ، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن ، فكأني لم آمن بمكانهما ، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه : يا عم ، أرني أبا جهل ، فقلت : يا ابن أخي ، وما تصنع به ؟ ، قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه ، فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله ، فأشرت لهما إليه ، فشدا عليه – أي انطلقا نحوه - مثل الصقرين حتى ضرباه " وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما.
وانجلت المعركة عن خسارة فادحة لقريش ، فقد قٌُتل سبعون رجلاً من أشرافهم ، وأُسر منهم سبعون ، فولّوا الأدبار يجرّون أذيال الخيبة ، بينما لم يُقتل من المسلمين سوى أربعة عشر شهيداً ، قدّموا أرواحهم قرباناً لهذا النصر العظيم ، الذي ذاق المسلمون حلاوته ، وخلّد الله ذكره في سورة كاملة ، ليبقى شاهد حقٍ على نُصرة الله لأوليائه ودفاعهم عنه .

منتديات عرب مسلم | منتدى برامج نت | منتدى عرب مسلم | منتديات برامج نت | منتدى المشاغب | منتدى فتكات | منتديات مثقف دوت كوم | منتديات العرب | إعلانات مبوبة مجانية | إعلانات مجانية | اعلانات مبوبة مجانية | اعلانات مجانية | القرآن الكريم | القرآن الكريم قراءة واستماع | المكتبة الصوتية للقران الكريم mp3 | مكتبة القران الكريم mp3 | ترجمة القرآن | القرآن مع الترجمة | أفضل ترجمة للقرآن الكريم | ترجمة القرآن الكريم | Quran Translation | Quran with Translation | Best Quran Translation | Quran Translation Transliteration | تبادل إعلاني مجاني