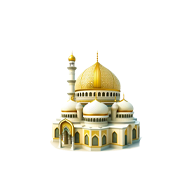8-
وفي هذه المعركة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة وقد قتلها خالد
بن الوليد ، والناس متقصفون ( مزدحمون) عليها، فقال : ما هذا ؟ قالوا :
امرأة قتلها خالد بن الوليد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من
معه : أدرك خالدا ًفقل له :إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليداً ، أو امرأة ،
أوعسيفاً ( أجيراً ) ...
لاشك
في أن النهي عن قتل الضعفاء ، أو الذين لم يشتركوا في القتال ، كالرهبان ،
والنساء ، والشيوخ ، والأطفال ، أو الذين أجبروا على القتال ، كالفلاحين ،
والأجراء ( العمال) شيء تفرد به الإسلام في تاريخ الحروب تبيح للأمة
المحاربة قتل جميع فئات الشعب من أعدائها المحاربين بلا استثناء ، وفي هذا
العصر الذين أعلنت فيه حقوق الإنسان ، وقامت أكبر هيئة دولية عالمية لمنع
العدوان ، ومساندة الشعوب المستضعفة كما يقولون ، لم يبلغ الضمير الإنساني
من السمو والنبل حداً يعلن فيه تحريم قتل تلك الفئات من الناس ، وعهدنا
بالحربين العالميتين الأولى والثانية تدمير المدن فوق سكانها ، واستباحة
تقتيل من فيها تقتيلاً جماعياً ، كما كان عهدنا بالحروب الاستعمارية ضد
ثورات الشعوب التي تطلب بحقها في الحياة والكرامة .
إن
المستعمرين يستبيحون في سبيل إخماد تلك الثورات تخريب المدن والقرى وقتل
سكانها بالآلاف وعشرت الآلاف ، كما فعلت فرنسا أكثر من مرة في الجزائر ،
وكما فعلت إنجلترا في أكثر من مستعمرة من مستعمراتها ، وكما تفعل اليوم
البرتغال في مستعمراتها في إفريقيا .
كما
أننا لم نعهد قط في تاريخ شعب من شعوب العالم القديم والحديث النهي عن قتل
العمال والفلاحين الذين يجبرون على الحرب جبراً ، ولكن الاسلام جاء قبل
أربعة عشر قرناً بالنهي الصريح عن قتلهم ، ولم يقتصر الأمر على مجرد النهي
تشريعاً ، بل كان ذلك حقيقة وواقعاً ، فهناك في معركة حنين ترى الرسول صلى
الله عليه وسلم نفسه وهو صاحب الشرعية ومبلغها عن الله إلى الناس ، يغضب
لقتل امرأة ، ويرسل إلى بعض قواده أن لا يتعرض للنساء والأطفال والأجراء ،
وحين جهز جيش أسامة لقتال الروم ـ قبل وفاته بأيام ـ كان مما أوصاهم به :
الامتناع عن قتل النساء ، والأطفال ، والعجزة ، والرهبان الذين لا يقاتلون ،
أولا يعينون على قتال ، وكذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين أنفذ
بعث اسامة ، وحين كان يوجه الجيوش للقتال في سبيل الله : في سبيل الحق
والخير والهدى والعدالة ،
وكذلك
فعل سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه في كل مكان ، وفي مختلف العصور
هذه المبادئ الإنسانية النبيلة التي لم يعرفها تاريخ جيش من جيوش الأرض ،
وبذلك على حرص الجيش الإسلامي على هذه التقاليد معاملة صلاح الدين للصلبيين
بعد أن انتصر عليهم ، واسترد منهم بيت المقدس ، فقد أعطى الأمان للشيوخ ،
ورجال الدين ، والنساء ، والأطفال ، بل وللمحاربين الأشداء ، فوصلهم إلى
جماعاتهم بحراسة الجيش الإسلامي ، لم يمسسهم سوء ، بينما كان والوحشية ،
والدناءة ، فقد أمن الصليبيون سكان بيت المقدس المسلمين على أرواحهم
وأموالهم ، إذا رفعوا الراية البيضاء فوق المسجد الأقصى ، فاحتشد فيه
المسلمون مخدوعين بهذا العهد ، فلما دخل الصليبيون بيت المقدس ذبحوا كل من
التجأ إلى المسجد الأقصى تذبيحاً عاماً ، وقد بلغ من ذبحوا فيه سبعين ألفاً
من العلماء والزهاد ، والنساء والأطفال ، حتى إن كاتباً صليبياً رفع
البشارة بهذا الفتح المبين إلى البابا ، وقال فيه مباهياً : لقد سالت
الدماء في الشوارع حتى كان فرسان الصليبين يخوضون في الدماء إلى قوائم
خيولهم .
إننا
لا نقول اليوم هذا للمفاخرة والمباهاة بتاريخ فتوحاتنا وقوادنا وجيوشنا
التي قال فيا " لوبون " : " ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم ولا أعدل من العرب "
وإنما نقول هذا لننبه إلى إننا كنا أرحم بالإنسانية وأبر بها من هؤلاء
الغربيين وهم في القرن العشرين ، وإلى أن هؤلاء الغربيين حين يتحدثون الينا
عن حقوق الإنسان ويوم الأطفال ، ويوم الأمهات ، تدليلاً منهم على سمو
حضارتهم إنما يخدعوننا نحن ، بل يخدعون السذج والسخفاء ، وفاقدي الثقة
بأمتهم وتاريخهم ممن يزعمون أنهم أبناؤنا ومثقفونا .
نريد
أن يكون جيلنا المعاصر واعياً لهذه الدسائس ، واثقاً بدينه وتراثه الحضاري
الانساني النبيل ، فلا يخضع لهؤلاء الغربيين خضوع الفقير الذليل أمام
الغني القوي ، ولا يتهافت على زادهم الفكري دون تمييز بين غثه وسمينه ،
تهافت الفراش على النار ليحترق بها .
لقد
أثبت العالم أن الإسلام خير الأديان ، وأقربها إلى فطرة الإنسان ، وأضمنها
لصلاح الناس ، وأثبت التاريخ أن حروب الإسلام أرحم الحروب وأقلها بلاءاً ،
وأكثرها خيراً ، وأنبلها هدفاً ، وفي كل يوم جديد برهان جديد على أن
الإسلام دين الله ، وأن محمداً رسول الله ،وأن المسلمين الصادقين صفوة عباد
الله وخيرتهم من الناس أجمعين. ( سَنُرِيهِمْ آيَاِتنَا فِي الآفَاقِ
وَفِي أنْفِسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنَّهُ الحَقُّ ، أوَلمْ
يَكْفِ بِرَبِّكَ أنَّهُ عَلى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ) [ فصلت : 53] .
9-
بعد أن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من انهزم من هوازن على
ثقيف بالطائف ، وحاصرها أياماً فلم تفتح عليه ، عاد إلى المدينة وفي
الطريق قسم غنائم معركة حنين ، وكانت ستة آلاف من الذراري والنساء ، ومن
الأبل والشياه مالا يدري عدته ، وقد أعطى قسماً كبيراً منها للاشراف من
العرب يتألفهم على الاسلام ، وأعطى كثيراً منها لقريش ولم يعط منها
للأنصار شيئاً ، وتكلم بعضهم في ذلك متألمين من حرمانهم من هذه الغنائم ،
حتى قال بعضهم : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ، أي إنه لم يعد
يذكرنا بعد أن فتح الله مكة ودانت قريش بالاسلام ، فجمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم الأنصار وخطب فيهم فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : " يا معشر
الأنصار ! مقالة بلغني عنكم ، وجدة ( أي عتب ) وجدتموها على في أنفسكم ؟
ألم تكونوا ضلاًلاً فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف الله
بين قلوبكم ؟ " بلى ! الله ورسوله أمن وأفضل . ثم قال : " ألا تجيبونني
يا معشر الأنصار " ؟ قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ؟لله ولرسوله المن
والفضل ، " أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم : أتيناك مكذباً فصدقناك ،
ومخذولاً فنصرناك ، وطريداً فأويناك ، وعائلاً فأسيناك ، أوجدتم يا معشر
الأنصار في أنفسكم في لعاعة ( البقية اليسيرة ) من الدنيا تألفت بها قوماً
ليسلموا ، وتركتكم إلى إسلامكم ، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس
بالشاة والبعير ، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فو الذي نفس محمد بيده ،
لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ، ولو سلك الناس شعباً ( هو الطريق
بين جبلين ) وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ، اللهم أرحم الأنصار ،
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار " فبكي القوم حق أخضلوا ( بللوا )
لحاهم ، وقالوا : رضينا برسول الله قسماً وحظاً .
وها هنا مسائل يمكن التعليق عليها :
أولاً :
قضية الغنائم كجزء من نظام الحرب في الإسلام ، وقد اتخذها أعداؤه وسيلة
للطعن فيه على أنها باعث مادي من بواعث إعلان الحرب في الإسلام ، ومنشط
فعال للجنود والمسلمين يدفعون إلى التضحية والفداء ، ولذلك يتهافتون عليها
بعد الحرب ، كما في هذه المعركة ، ولا ريب في أن كل منصف يرفض هذا الادعاء ،
فبواعث الحرب في الاسلام معنوية تهدف إلى نشر الحق ، ودفع الأذى والعدوان ،
وهذا ما صرحت به آيات وأحاديث كثيرة صريحة ، ومن الغرابة بمكان أن يضحي
الإنسان بحياته ، ويعرض مستقبل أسرته للضياع ، طمعاً في مغنم مادي مهما كبر
، والطمع في المغانم المادية لا يمكن أن يؤدي إلى البطولات الخارقة التي
بدت من المحاربين المسلمين في صدر الإسلام ، ولا يمكن أن يؤدي إلى النتائج
المذهلة التي انتهت اليها معارك الإسلام مع العرب في حياة الرسول ، والتي
انتهت اليها معاركه مع فارس والروم فيما بعد ، على أن أعداء الإسلام لم تكن
تنقصهم المطامع المادية ، فغنيمة أموال المسلمين ورقابهم في حال هزيمتهم
كانت من نصيب أعدائهم حتماً ،
ولم
يكن المسلمون وحدهم هم الذين يقتسمون أموال أعدائهم ورقابهم عند الانتصار
عليهم ، بل كان هذا شأن كل جيوش المتحاربين فلماذا لم تؤد المطابع المادية
عند الأعداء إلى البطولات الخارقة ، والنتائج المذهلة التي كانت تبدو من
الجنود المسلمين ، والتي أسفرت عنها الحروب الإسلامية ؟ وفي وقائع الحروب
الإسلامية ما ينفي نفياً قاطعاً بأن الدوافع المادية كانت هي الباعث
الرئيسي في نفس الجندي المسلم ، ففي معارك بدر ، وأحد ، ومؤته ، وغيرها كان
البطل المسلم يتقدم إلى المعركة مؤملاً في إحراز شرف الشهادة ونعيم الجنة ،
حتى كان أحدهم يقذف بالتمرة من فمه حين يسمع وعد الرسول للشهداء بالجنة ،
ويخوض المعكرة وهو يقول : بخ بخ ، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا هذه
التمرات ، والله إنها لمسافة بعيدة ، ثم ما يزال يقاتل حتى يقتل ،
وكان
أحدهم يبرز لقتال الأعداء وهو يقول الجنة ّ! والله إني لأجد ريحها دون أحد
( أي أقرب من جبل أحد ، وكان ذلك في معركة احد ) . وفي معارك الفرس كان
جواب قائد الوفد المسلم لرستم حين عرض أن يدفع للمسلمين أموالاً أو ثياباً
ليعدلوا عن الحرب ويرجعوا إلى بلادهم ، والله ما هذا الذي خرجنا من أجله ،
وإنما نريد إنقاذكم من عبادة العباد الى عبادة الواحد القهار ، فإن انتم
أسلمتم رجعنا عنكم ويبقى ملككم لكم ، وأرضكم لكم ، لا ننازعكم في شيء منها
.. فهل هذا جواب جماعة خرجوا للمغانم والاستيلاء على الأرضي والأموال . أما
أن يستشهد لتلك الدعوى الباطلة بما حصل عند تقسيم الغنائم بعد معركة حنين
من استشراف نفوس كثيرين من المحاربين إليها ، وموجدة الانصار لحرمانهم منها
، فذلك المغانم من حديثي العهد بالإسلام الذين لم تتمكن هداية الإسلام من
نفوسهم كما تمكنت من السابقين إليه ، ولذلك لم يستشرف لها أمثال أبي بكر ،
وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عوف ، وطلحة ، والزبير ، من كبار الصحابة
السابقين إلى دعوة الإسلام ، وما حصل من الأنصار إنما كانت مقالة بعضهم ممن
رأوا في تقسيم الغنائم يومئذ تفضيل بعض المحاربين على بعض في مكاسب النصر ،
وهذا يقع من أكثر الناس في كل عصر ، وفي كل مكان ، وهذا المعنى مما يجده
كل إنسان في نفسه في مثل تلك الظروف .
وليس
أدل على إرادة رضي الله وثوابه وجنته ، وطاعة رسوله عند الأنصار ، من
بكائهم حين خطب صلى الله عليه وسلم فيهم ، وكان مما قاله لهم : " ألا
تريدون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى رحالكم " ؟ فمن فضلوا صحبة رسوله وقربهم منه وسكناه بينهم على
الأموال والمكاسب ،أيصح أن يقال فيهم : إنهم إنما جاهدوا للأموال والمكاسب ؟
ولا
معنى لأن يقال : لماذا جعل الاسلام الغنائم من نصيب المحاربين ، ولم
يجعلها من نصيب الدولة كما في عصرنا هذا ؟ لأن القول بذلك غفلة عن طبيعة
الناس ، وتقاليد الحروب في تلك العصور ، فلم يكن الجيش الاسلامي وحده دون
الجيش الفارسي أو الرومي هو الذي يقتسم أفراده أربعة أخماس الغنائم ، بل
كان ذلك شأن الجيوش كلها ، ولو أن مجتهداً اليوم ذهب إلى أن غنائم الجيش
الإسلامي في عصرنا الحاضر تعطي للدولة ، لما كان بعيداً عن فقه هذه المسألة
وفق مبادئ الاسلام وروحه .
ثانياً
ـ أن إغداق العطاء للذين أسلموا حديثاً ، يدل على حكمة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، ومعرفته بطبائع قومة ، وبعد نظره في تصريف الأمور ، فهؤلاء
الذين ظلموا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويمتنعون عن قبول
دعوته ، حتى فتح مكة ، والذين أظهر بعضهم الشماتة بهزيمة المسلمين أول
المعركة ، لا بد من تأليف قلوبهم على الاسلام وإشعارهم بفضل دخولهم فيه من
الناحية المادية التي كانوا يحاربونه من أجلها ، إذ كانوا ـ في الحقيقة ـ
إنما يحاربونه وهم أشراف القوم إبقاء على زعامتهم ، وحفاظاً على مصالحهم
المادية ،فلما خضد الاسلام من شوكتهم بفتح مكة ، كان من الممكن أن يظلوا
في قرارة أنفسهم حاقدين على هذا النصر ، واجدين من هزيمتهم وانكسارهم ،
والاسلام دين هداية وإصلاح ، فلا يكتفي بفرض سلطانه بالقهر والغلبة ، كما
تفعل كثير من النظم التي تعتمد في قيامها وبقائها على القوة دون استجابة
النفوس والقلوب ، بل لا بد من تفتح القلوب له ، واستبشارها بهدايته ،
وتعشقها لمبادئه ومثله ، وما دام العطاء عند بعض الناس مفيداً في استصلاح
قلوبهم وغسل عداوتهم، فالحكمة كل الحكمة أن تعطي حتى ترضى ، كما فعل رسول
الله صلى الله عليه وسلم .
ولقد
علم الله أن دعوته التي انتصرت اخيراً في جزيرة العرب ، لا بد من أن تمتد
إلى شرق الدنيا وغربها ، فلا بد من إعداد العرب جميعهم لحمل هذه الرسالة ،
والتضحية في سبيلها فإذا صلحت نفوس أشرافهم بهذه الاعطيات ، وتفتحت قلوبهم
بعد ذلك لنور الدعوة ، وحمل أعباءها ، وهذا هو الذي حصل ، فانه بعد أن تألف
رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب هؤلاء الزعماء ، زالت من نفوسهم كل
موجدة وحقد على الاسلام ودعوته ، فلما أنساح الجيش الاسلامي في الأرض
للتبشير بمبادئ الاسلام ، إخراج الناس من ظلمتهم إلى نوره ، كانت الجزيرة
العربية مستعدة لهذا العمل التاريخي العظيم ، وكان هؤلاء الرؤساء المؤلفة
قلوبهم من أوائل الراضين المندفعين لخوض معركة التحرير ، وقد أثبت التاريخ
بلاء كثير منهم في الفتوحات بلاءً حسناً ، كما كان لكثير منهم بعد ذلك فضل
كبير في تثبيت دعائم الإسلام خارج الجزيرة ، وإرادة مملكته الواسعة ،
وقيادة جيوشه المتدفقة .
ولا
يضر هؤلاء المجاهدين أنهم كانوا في أول إسلامهم ممن ألفت قلوبهم على
الإسلام ، أو تأخر دخولهم فيه عن فتح مكة ، فكثيراً ما يلحق المتأخر
بالسابق ، ويدرك الضعيف فضل القوى ، ويخلص العمل من لم يبدأ مخلصاً ، وقد
قال الحسن رحمه الله : طلبنا هذا العلم لغير الله ، فأبى إلا أن يكون لله .
وقال غيره : طلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فيه نية ، ثم حضرتنا النية بعد .
وحسب المتأخرين أن الله وعدهم بالحسنى ،كما قال تعالى ؟ ( لا يَسْتَوى
مِنْكُمْ مَنْ أنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلْ أوْلئِكَ أعْظَمُ
دَرَجَةً مِنَ الذِينَ أنفَقُوا مِنْ بَعْدُ ، وَقَاتلُوا ، وَكُلاً وَعَدَ
اللهُ الحُسْنَى ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلونَ خَبِيرٌ ) [ الحديد : 10] .
ثالثاً
ـ وفي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار واسترضائهم على حرمانهم
من المغانم ، دليل على حسن سياسته صلى الله عليه وسلم ، ودماثه خلقه ، فهو
حين بلغه ما قاله بعضهم بشأن الغنائم ، اهتم باسترضائهم وجمعهم لذلك ، وقال
لهم ذلك القول الحكيم مع أنه يعلم أنهم يحبونه ويتبعونه ، وقد بذلوا في
سبيل الله دماءهم وأموالهم ، فليس يخشى عليهم ما ينقص من أيمانهم ، ، ولكنه
أحب أن يزيل ما علق في أذهان بعضهم حول هذا الموضوع ، وتلك سنة حميدة يجب
أن يتبعها القادة والزعماء مع أنصارهم ومحبيهم ، فإن الأعداء متربصون
لاستغلال كل حادثة أو قول يضعف تعلق المحبين بقادتهم ، والشيطان خبيث الدس ،
سريع المكر ، فلا يهمل القادة استرضاء أنصارهم مهما وثقوا بهم .
ثم
أنظر إلى ذلك الأسلوب الحكيم المؤثر الذي سلكه عليه الصلاة والسلام
لاسترضائهم وإقناعهم بحكمه ما فعل ، فقد ذكر فضلهم على دعوة الإسلام ،
ونصرتهم لرسوله ، ومبادرتهم إلى التصديق به حيث كذبه قومه وطاردوه ، بعد أن
ذكرهم بفضل الله عليه في إنقاذهم من الضلالة والشتات والعداوة ليسهل
عليهم كل ما فاتهم من مال الدنيا بجانب ما ربحوه من السعادة والهداية ،
وبذلك أكد لهم أمرين : أنه لم ينحز إلى قومه وينسى هؤلاء ، أنه كان حين
حرمهم الغنائم ، إنما كان يعتمد على قوة دينهم ، وعظيم إيمانهم ، وحبهم لله
ولرسوله ، و ليس بعد هذا الأسلوب أسلوب أبلغ في استرضاء ذوي الفضل والسبق
في الدعوة ممن آمنوا بها مخلصين صادقين ، لا يرجون جزاءً ولا شكوراً . فصلى
الله وسلم عليه ما أصدق قول الله فيه: ( وَإنَّكَ لعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) [
ن : 5].
رابعاً
ـ ان موقف الأنصار بعد أن سمعوا كلامه ، أروع الأمثلة في صدق الإيمان ،
ورقة القلوب ، وتذكر فضل الله في الهداية والتقوى ، فقد ذكروا أن الفضل لله
ولرسوله فيما قاموا به من النصرة والتأييد والجهاد ، وأنهم لولا الله لما
اهتدوا ، ولولا رسوله لما استضاءت قلوبهم وبصائرهم ، ولولا الإسلام لما جمع
الله شملهم بعد الشتات ، وصان دماءهم بعد الهدر ، وأنقذهم من سيطرة اليهود
إلى عز الإسلام وخلصهم من جيرانهم المستغلين ، ثم أعلنوا إيثارهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم على كل ما تفيض به الدنيا من مال ومتاع ، ولما دعا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لهم ، ولأولادهم ولأولاد أولادهم .
سالت مدامعهم فرحاً بعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ودعوته
المستجابة لهم ، فهل بعد هذا دليل على صدق الإيمان ، وهل هناك حب اسمي
وأروع من هذا الحب ؟ رضي الله عنهم وأرضاهم ، وخالد ذكراهم في العالمين ،
وألحقنا بهم في جنات النعيم ، مع رسوله الحبيب العظيم ، والذين أنعم الله
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والمقربين .
وأخيراً
فان هذا الموقف وما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار ، مما
يجب أن يتذكره كل داعية ، وأن يحفظه كل طالب علم ، فانه مما يزيد في
الإيمان ، ويهيج لواعج الحب والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين .
وفي هذه المعركة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة وقد قتلها خالد
بن الوليد ، والناس متقصفون ( مزدحمون) عليها، فقال : ما هذا ؟ قالوا :
امرأة قتلها خالد بن الوليد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من
معه : أدرك خالدا ًفقل له :إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليداً ، أو امرأة ،
أوعسيفاً ( أجيراً ) ...
لاشك
في أن النهي عن قتل الضعفاء ، أو الذين لم يشتركوا في القتال ، كالرهبان ،
والنساء ، والشيوخ ، والأطفال ، أو الذين أجبروا على القتال ، كالفلاحين ،
والأجراء ( العمال) شيء تفرد به الإسلام في تاريخ الحروب تبيح للأمة
المحاربة قتل جميع فئات الشعب من أعدائها المحاربين بلا استثناء ، وفي هذا
العصر الذين أعلنت فيه حقوق الإنسان ، وقامت أكبر هيئة دولية عالمية لمنع
العدوان ، ومساندة الشعوب المستضعفة كما يقولون ، لم يبلغ الضمير الإنساني
من السمو والنبل حداً يعلن فيه تحريم قتل تلك الفئات من الناس ، وعهدنا
بالحربين العالميتين الأولى والثانية تدمير المدن فوق سكانها ، واستباحة
تقتيل من فيها تقتيلاً جماعياً ، كما كان عهدنا بالحروب الاستعمارية ضد
ثورات الشعوب التي تطلب بحقها في الحياة والكرامة .
إن
المستعمرين يستبيحون في سبيل إخماد تلك الثورات تخريب المدن والقرى وقتل
سكانها بالآلاف وعشرت الآلاف ، كما فعلت فرنسا أكثر من مرة في الجزائر ،
وكما فعلت إنجلترا في أكثر من مستعمرة من مستعمراتها ، وكما تفعل اليوم
البرتغال في مستعمراتها في إفريقيا .
كما
أننا لم نعهد قط في تاريخ شعب من شعوب العالم القديم والحديث النهي عن قتل
العمال والفلاحين الذين يجبرون على الحرب جبراً ، ولكن الاسلام جاء قبل
أربعة عشر قرناً بالنهي الصريح عن قتلهم ، ولم يقتصر الأمر على مجرد النهي
تشريعاً ، بل كان ذلك حقيقة وواقعاً ، فهناك في معركة حنين ترى الرسول صلى
الله عليه وسلم نفسه وهو صاحب الشرعية ومبلغها عن الله إلى الناس ، يغضب
لقتل امرأة ، ويرسل إلى بعض قواده أن لا يتعرض للنساء والأطفال والأجراء ،
وحين جهز جيش أسامة لقتال الروم ـ قبل وفاته بأيام ـ كان مما أوصاهم به :
الامتناع عن قتل النساء ، والأطفال ، والعجزة ، والرهبان الذين لا يقاتلون ،
أولا يعينون على قتال ، وكذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين أنفذ
بعث اسامة ، وحين كان يوجه الجيوش للقتال في سبيل الله : في سبيل الحق
والخير والهدى والعدالة ،
وكذلك
فعل سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه في كل مكان ، وفي مختلف العصور
هذه المبادئ الإنسانية النبيلة التي لم يعرفها تاريخ جيش من جيوش الأرض ،
وبذلك على حرص الجيش الإسلامي على هذه التقاليد معاملة صلاح الدين للصلبيين
بعد أن انتصر عليهم ، واسترد منهم بيت المقدس ، فقد أعطى الأمان للشيوخ ،
ورجال الدين ، والنساء ، والأطفال ، بل وللمحاربين الأشداء ، فوصلهم إلى
جماعاتهم بحراسة الجيش الإسلامي ، لم يمسسهم سوء ، بينما كان والوحشية ،
والدناءة ، فقد أمن الصليبيون سكان بيت المقدس المسلمين على أرواحهم
وأموالهم ، إذا رفعوا الراية البيضاء فوق المسجد الأقصى ، فاحتشد فيه
المسلمون مخدوعين بهذا العهد ، فلما دخل الصليبيون بيت المقدس ذبحوا كل من
التجأ إلى المسجد الأقصى تذبيحاً عاماً ، وقد بلغ من ذبحوا فيه سبعين ألفاً
من العلماء والزهاد ، والنساء والأطفال ، حتى إن كاتباً صليبياً رفع
البشارة بهذا الفتح المبين إلى البابا ، وقال فيه مباهياً : لقد سالت
الدماء في الشوارع حتى كان فرسان الصليبين يخوضون في الدماء إلى قوائم
خيولهم .
إننا
لا نقول اليوم هذا للمفاخرة والمباهاة بتاريخ فتوحاتنا وقوادنا وجيوشنا
التي قال فيا " لوبون " : " ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم ولا أعدل من العرب "
وإنما نقول هذا لننبه إلى إننا كنا أرحم بالإنسانية وأبر بها من هؤلاء
الغربيين وهم في القرن العشرين ، وإلى أن هؤلاء الغربيين حين يتحدثون الينا
عن حقوق الإنسان ويوم الأطفال ، ويوم الأمهات ، تدليلاً منهم على سمو
حضارتهم إنما يخدعوننا نحن ، بل يخدعون السذج والسخفاء ، وفاقدي الثقة
بأمتهم وتاريخهم ممن يزعمون أنهم أبناؤنا ومثقفونا .
نريد
أن يكون جيلنا المعاصر واعياً لهذه الدسائس ، واثقاً بدينه وتراثه الحضاري
الانساني النبيل ، فلا يخضع لهؤلاء الغربيين خضوع الفقير الذليل أمام
الغني القوي ، ولا يتهافت على زادهم الفكري دون تمييز بين غثه وسمينه ،
تهافت الفراش على النار ليحترق بها .
لقد
أثبت العالم أن الإسلام خير الأديان ، وأقربها إلى فطرة الإنسان ، وأضمنها
لصلاح الناس ، وأثبت التاريخ أن حروب الإسلام أرحم الحروب وأقلها بلاءاً ،
وأكثرها خيراً ، وأنبلها هدفاً ، وفي كل يوم جديد برهان جديد على أن
الإسلام دين الله ، وأن محمداً رسول الله ،وأن المسلمين الصادقين صفوة عباد
الله وخيرتهم من الناس أجمعين. ( سَنُرِيهِمْ آيَاِتنَا فِي الآفَاقِ
وَفِي أنْفِسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنَّهُ الحَقُّ ، أوَلمْ
يَكْفِ بِرَبِّكَ أنَّهُ عَلى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ) [ فصلت : 53] .
9-
بعد أن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من انهزم من هوازن على
ثقيف بالطائف ، وحاصرها أياماً فلم تفتح عليه ، عاد إلى المدينة وفي
الطريق قسم غنائم معركة حنين ، وكانت ستة آلاف من الذراري والنساء ، ومن
الأبل والشياه مالا يدري عدته ، وقد أعطى قسماً كبيراً منها للاشراف من
العرب يتألفهم على الاسلام ، وأعطى كثيراً منها لقريش ولم يعط منها
للأنصار شيئاً ، وتكلم بعضهم في ذلك متألمين من حرمانهم من هذه الغنائم ،
حتى قال بعضهم : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ، أي إنه لم يعد
يذكرنا بعد أن فتح الله مكة ودانت قريش بالاسلام ، فجمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم الأنصار وخطب فيهم فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : " يا معشر
الأنصار ! مقالة بلغني عنكم ، وجدة ( أي عتب ) وجدتموها على في أنفسكم ؟
ألم تكونوا ضلاًلاً فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف الله
بين قلوبكم ؟ " بلى ! الله ورسوله أمن وأفضل . ثم قال : " ألا تجيبونني
يا معشر الأنصار " ؟ قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ؟لله ولرسوله المن
والفضل ، " أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم : أتيناك مكذباً فصدقناك ،
ومخذولاً فنصرناك ، وطريداً فأويناك ، وعائلاً فأسيناك ، أوجدتم يا معشر
الأنصار في أنفسكم في لعاعة ( البقية اليسيرة ) من الدنيا تألفت بها قوماً
ليسلموا ، وتركتكم إلى إسلامكم ، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس
بالشاة والبعير ، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فو الذي نفس محمد بيده ،
لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ، ولو سلك الناس شعباً ( هو الطريق
بين جبلين ) وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ، اللهم أرحم الأنصار ،
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار " فبكي القوم حق أخضلوا ( بللوا )
لحاهم ، وقالوا : رضينا برسول الله قسماً وحظاً .
وها هنا مسائل يمكن التعليق عليها :
أولاً :
قضية الغنائم كجزء من نظام الحرب في الإسلام ، وقد اتخذها أعداؤه وسيلة
للطعن فيه على أنها باعث مادي من بواعث إعلان الحرب في الإسلام ، ومنشط
فعال للجنود والمسلمين يدفعون إلى التضحية والفداء ، ولذلك يتهافتون عليها
بعد الحرب ، كما في هذه المعركة ، ولا ريب في أن كل منصف يرفض هذا الادعاء ،
فبواعث الحرب في الاسلام معنوية تهدف إلى نشر الحق ، ودفع الأذى والعدوان ،
وهذا ما صرحت به آيات وأحاديث كثيرة صريحة ، ومن الغرابة بمكان أن يضحي
الإنسان بحياته ، ويعرض مستقبل أسرته للضياع ، طمعاً في مغنم مادي مهما كبر
، والطمع في المغانم المادية لا يمكن أن يؤدي إلى البطولات الخارقة التي
بدت من المحاربين المسلمين في صدر الإسلام ، ولا يمكن أن يؤدي إلى النتائج
المذهلة التي انتهت اليها معارك الإسلام مع العرب في حياة الرسول ، والتي
انتهت اليها معاركه مع فارس والروم فيما بعد ، على أن أعداء الإسلام لم تكن
تنقصهم المطامع المادية ، فغنيمة أموال المسلمين ورقابهم في حال هزيمتهم
كانت من نصيب أعدائهم حتماً ،
ولم
يكن المسلمون وحدهم هم الذين يقتسمون أموال أعدائهم ورقابهم عند الانتصار
عليهم ، بل كان هذا شأن كل جيوش المتحاربين فلماذا لم تؤد المطابع المادية
عند الأعداء إلى البطولات الخارقة ، والنتائج المذهلة التي كانت تبدو من
الجنود المسلمين ، والتي أسفرت عنها الحروب الإسلامية ؟ وفي وقائع الحروب
الإسلامية ما ينفي نفياً قاطعاً بأن الدوافع المادية كانت هي الباعث
الرئيسي في نفس الجندي المسلم ، ففي معارك بدر ، وأحد ، ومؤته ، وغيرها كان
البطل المسلم يتقدم إلى المعركة مؤملاً في إحراز شرف الشهادة ونعيم الجنة ،
حتى كان أحدهم يقذف بالتمرة من فمه حين يسمع وعد الرسول للشهداء بالجنة ،
ويخوض المعكرة وهو يقول : بخ بخ ، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا هذه
التمرات ، والله إنها لمسافة بعيدة ، ثم ما يزال يقاتل حتى يقتل ،
وكان
أحدهم يبرز لقتال الأعداء وهو يقول الجنة ّ! والله إني لأجد ريحها دون أحد
( أي أقرب من جبل أحد ، وكان ذلك في معركة احد ) . وفي معارك الفرس كان
جواب قائد الوفد المسلم لرستم حين عرض أن يدفع للمسلمين أموالاً أو ثياباً
ليعدلوا عن الحرب ويرجعوا إلى بلادهم ، والله ما هذا الذي خرجنا من أجله ،
وإنما نريد إنقاذكم من عبادة العباد الى عبادة الواحد القهار ، فإن انتم
أسلمتم رجعنا عنكم ويبقى ملككم لكم ، وأرضكم لكم ، لا ننازعكم في شيء منها
.. فهل هذا جواب جماعة خرجوا للمغانم والاستيلاء على الأرضي والأموال . أما
أن يستشهد لتلك الدعوى الباطلة بما حصل عند تقسيم الغنائم بعد معركة حنين
من استشراف نفوس كثيرين من المحاربين إليها ، وموجدة الانصار لحرمانهم منها
، فذلك المغانم من حديثي العهد بالإسلام الذين لم تتمكن هداية الإسلام من
نفوسهم كما تمكنت من السابقين إليه ، ولذلك لم يستشرف لها أمثال أبي بكر ،
وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عوف ، وطلحة ، والزبير ، من كبار الصحابة
السابقين إلى دعوة الإسلام ، وما حصل من الأنصار إنما كانت مقالة بعضهم ممن
رأوا في تقسيم الغنائم يومئذ تفضيل بعض المحاربين على بعض في مكاسب النصر ،
وهذا يقع من أكثر الناس في كل عصر ، وفي كل مكان ، وهذا المعنى مما يجده
كل إنسان في نفسه في مثل تلك الظروف .
وليس
أدل على إرادة رضي الله وثوابه وجنته ، وطاعة رسوله عند الأنصار ، من
بكائهم حين خطب صلى الله عليه وسلم فيهم ، وكان مما قاله لهم : " ألا
تريدون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى رحالكم " ؟ فمن فضلوا صحبة رسوله وقربهم منه وسكناه بينهم على
الأموال والمكاسب ،أيصح أن يقال فيهم : إنهم إنما جاهدوا للأموال والمكاسب ؟
ولا
معنى لأن يقال : لماذا جعل الاسلام الغنائم من نصيب المحاربين ، ولم
يجعلها من نصيب الدولة كما في عصرنا هذا ؟ لأن القول بذلك غفلة عن طبيعة
الناس ، وتقاليد الحروب في تلك العصور ، فلم يكن الجيش الاسلامي وحده دون
الجيش الفارسي أو الرومي هو الذي يقتسم أفراده أربعة أخماس الغنائم ، بل
كان ذلك شأن الجيوش كلها ، ولو أن مجتهداً اليوم ذهب إلى أن غنائم الجيش
الإسلامي في عصرنا الحاضر تعطي للدولة ، لما كان بعيداً عن فقه هذه المسألة
وفق مبادئ الاسلام وروحه .
ثانياً
ـ أن إغداق العطاء للذين أسلموا حديثاً ، يدل على حكمة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، ومعرفته بطبائع قومة ، وبعد نظره في تصريف الأمور ، فهؤلاء
الذين ظلموا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويمتنعون عن قبول
دعوته ، حتى فتح مكة ، والذين أظهر بعضهم الشماتة بهزيمة المسلمين أول
المعركة ، لا بد من تأليف قلوبهم على الاسلام وإشعارهم بفضل دخولهم فيه من
الناحية المادية التي كانوا يحاربونه من أجلها ، إذ كانوا ـ في الحقيقة ـ
إنما يحاربونه وهم أشراف القوم إبقاء على زعامتهم ، وحفاظاً على مصالحهم
المادية ،فلما خضد الاسلام من شوكتهم بفتح مكة ، كان من الممكن أن يظلوا
في قرارة أنفسهم حاقدين على هذا النصر ، واجدين من هزيمتهم وانكسارهم ،
والاسلام دين هداية وإصلاح ، فلا يكتفي بفرض سلطانه بالقهر والغلبة ، كما
تفعل كثير من النظم التي تعتمد في قيامها وبقائها على القوة دون استجابة
النفوس والقلوب ، بل لا بد من تفتح القلوب له ، واستبشارها بهدايته ،
وتعشقها لمبادئه ومثله ، وما دام العطاء عند بعض الناس مفيداً في استصلاح
قلوبهم وغسل عداوتهم، فالحكمة كل الحكمة أن تعطي حتى ترضى ، كما فعل رسول
الله صلى الله عليه وسلم .
ولقد
علم الله أن دعوته التي انتصرت اخيراً في جزيرة العرب ، لا بد من أن تمتد
إلى شرق الدنيا وغربها ، فلا بد من إعداد العرب جميعهم لحمل هذه الرسالة ،
والتضحية في سبيلها فإذا صلحت نفوس أشرافهم بهذه الاعطيات ، وتفتحت قلوبهم
بعد ذلك لنور الدعوة ، وحمل أعباءها ، وهذا هو الذي حصل ، فانه بعد أن تألف
رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب هؤلاء الزعماء ، زالت من نفوسهم كل
موجدة وحقد على الاسلام ودعوته ، فلما أنساح الجيش الاسلامي في الأرض
للتبشير بمبادئ الاسلام ، إخراج الناس من ظلمتهم إلى نوره ، كانت الجزيرة
العربية مستعدة لهذا العمل التاريخي العظيم ، وكان هؤلاء الرؤساء المؤلفة
قلوبهم من أوائل الراضين المندفعين لخوض معركة التحرير ، وقد أثبت التاريخ
بلاء كثير منهم في الفتوحات بلاءً حسناً ، كما كان لكثير منهم بعد ذلك فضل
كبير في تثبيت دعائم الإسلام خارج الجزيرة ، وإرادة مملكته الواسعة ،
وقيادة جيوشه المتدفقة .
ولا
يضر هؤلاء المجاهدين أنهم كانوا في أول إسلامهم ممن ألفت قلوبهم على
الإسلام ، أو تأخر دخولهم فيه عن فتح مكة ، فكثيراً ما يلحق المتأخر
بالسابق ، ويدرك الضعيف فضل القوى ، ويخلص العمل من لم يبدأ مخلصاً ، وقد
قال الحسن رحمه الله : طلبنا هذا العلم لغير الله ، فأبى إلا أن يكون لله .
وقال غيره : طلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فيه نية ، ثم حضرتنا النية بعد .
وحسب المتأخرين أن الله وعدهم بالحسنى ،كما قال تعالى ؟ ( لا يَسْتَوى
مِنْكُمْ مَنْ أنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلْ أوْلئِكَ أعْظَمُ
دَرَجَةً مِنَ الذِينَ أنفَقُوا مِنْ بَعْدُ ، وَقَاتلُوا ، وَكُلاً وَعَدَ
اللهُ الحُسْنَى ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلونَ خَبِيرٌ ) [ الحديد : 10] .
ثالثاً
ـ وفي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار واسترضائهم على حرمانهم
من المغانم ، دليل على حسن سياسته صلى الله عليه وسلم ، ودماثه خلقه ، فهو
حين بلغه ما قاله بعضهم بشأن الغنائم ، اهتم باسترضائهم وجمعهم لذلك ، وقال
لهم ذلك القول الحكيم مع أنه يعلم أنهم يحبونه ويتبعونه ، وقد بذلوا في
سبيل الله دماءهم وأموالهم ، فليس يخشى عليهم ما ينقص من أيمانهم ، ، ولكنه
أحب أن يزيل ما علق في أذهان بعضهم حول هذا الموضوع ، وتلك سنة حميدة يجب
أن يتبعها القادة والزعماء مع أنصارهم ومحبيهم ، فإن الأعداء متربصون
لاستغلال كل حادثة أو قول يضعف تعلق المحبين بقادتهم ، والشيطان خبيث الدس ،
سريع المكر ، فلا يهمل القادة استرضاء أنصارهم مهما وثقوا بهم .
ثم
أنظر إلى ذلك الأسلوب الحكيم المؤثر الذي سلكه عليه الصلاة والسلام
لاسترضائهم وإقناعهم بحكمه ما فعل ، فقد ذكر فضلهم على دعوة الإسلام ،
ونصرتهم لرسوله ، ومبادرتهم إلى التصديق به حيث كذبه قومه وطاردوه ، بعد أن
ذكرهم بفضل الله عليه في إنقاذهم من الضلالة والشتات والعداوة ليسهل
عليهم كل ما فاتهم من مال الدنيا بجانب ما ربحوه من السعادة والهداية ،
وبذلك أكد لهم أمرين : أنه لم ينحز إلى قومه وينسى هؤلاء ، أنه كان حين
حرمهم الغنائم ، إنما كان يعتمد على قوة دينهم ، وعظيم إيمانهم ، وحبهم لله
ولرسوله ، و ليس بعد هذا الأسلوب أسلوب أبلغ في استرضاء ذوي الفضل والسبق
في الدعوة ممن آمنوا بها مخلصين صادقين ، لا يرجون جزاءً ولا شكوراً . فصلى
الله وسلم عليه ما أصدق قول الله فيه: ( وَإنَّكَ لعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) [
ن : 5].
رابعاً
ـ ان موقف الأنصار بعد أن سمعوا كلامه ، أروع الأمثلة في صدق الإيمان ،
ورقة القلوب ، وتذكر فضل الله في الهداية والتقوى ، فقد ذكروا أن الفضل لله
ولرسوله فيما قاموا به من النصرة والتأييد والجهاد ، وأنهم لولا الله لما
اهتدوا ، ولولا رسوله لما استضاءت قلوبهم وبصائرهم ، ولولا الإسلام لما جمع
الله شملهم بعد الشتات ، وصان دماءهم بعد الهدر ، وأنقذهم من سيطرة اليهود
إلى عز الإسلام وخلصهم من جيرانهم المستغلين ، ثم أعلنوا إيثارهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم على كل ما تفيض به الدنيا من مال ومتاع ، ولما دعا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لهم ، ولأولادهم ولأولاد أولادهم .
سالت مدامعهم فرحاً بعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ودعوته
المستجابة لهم ، فهل بعد هذا دليل على صدق الإيمان ، وهل هناك حب اسمي
وأروع من هذا الحب ؟ رضي الله عنهم وأرضاهم ، وخالد ذكراهم في العالمين ،
وألحقنا بهم في جنات النعيم ، مع رسوله الحبيب العظيم ، والذين أنعم الله
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والمقربين .
وأخيراً
فان هذا الموقف وما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار ، مما
يجب أن يتذكره كل داعية ، وأن يحفظه كل طالب علم ، فانه مما يزيد في
الإيمان ، ويهيج لواعج الحب والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين .